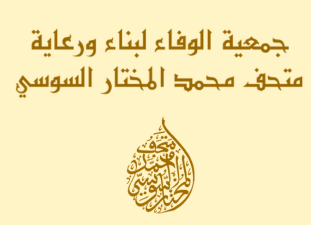قَبَس الأنوار من سيرة العلامة السوسي سيدي محمد المختار
(قراءة في المسار العلمي والوطني للعلامة سيدي محمد المختار السوسي
بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لوفاته)
إعداد: الحبيب الدرقاوي
في 29 جمادى الثانية عام 1383هـ، الموافق لـ: 17 نونير 1963م، فقد المغرب علما من أعلامه، ورائدا كبيرا من رواد نهضته، وعالما فذا من علمائه، ومؤخرا ثبتا من مؤرخيه، وباحثا منقبا من أوسع الباحثين المعاصرين دراية بالتاريخ المغربي؛ ذلكم هو أخونا المرحوم السيد المختار السوسي.
وإذا كانت ثلاثة وخمسين سنة قد مضت على وفاة هذا الرجل فذ، فمن حقه علينا أن لا ننساه، وأن نعرف بشخصيته الأجيالَ الجديدة التي لا تعرف عن روادها الأولين إلا النَّزْر اليسير.
لقد نشأ المختار السوسي في «إِلْغ»؛ وهي قرية من قرى سوس، تقع في ناحية «تَازْرْوَالْت» في الجنوب المغربي، وفي هذه القرية القاحلة القفراء البعيدة عن العمران، الجافة الطبيعة، تلقى دروسه الأولى عن والده أولا، وعن معلمي القرية الذين كانوا يلتفون حول والده باعتباره شيخا مربيا من أكابر الشيوخ المربين في سوس.
ولما اشتد عوده، وتخطى العقد الأول من عمره، انكب على دراسة العلوم العربية، التي كان لها شأن وأي شأن في الأراضي السوسية، وهكذا أخذ عن جملة علمائها الأعلام، أمثال شيخه الطاهر الإفراني، الذي كان يعتبر شيخ الأدب العربي، والأستاذ السيد عبد الرحمان البوزاكارني المستشهد بالرباط، وغيرهما من الشيوخ والأستاذة الكبار.
وكان ينمي معلوماته بكثرة مطالعة الكتب الأدبية والتاريخية على اختلافها، فكان كما قال عن نفسه: لا يختم كتابا إلا ويشرع في آخر، فمن “ألف ليلة وليلة” التي طالعها وهو ابن عشر سنوات، إلى “المستطرف”، و”حياة الحيوان”، وابن خلكان، و”مروج الذهب”، و”نفح الطيب”، إلى “قلائد العقيان”، و”الاستقصا”، و”نزهة الحادي”، إلى كل الكتب التي تتصل بالأدب والتاريخ، والتي تصل إليها يده، وكان لسان حاله -كما قال- ينشد قول ابن المعتز:
قلبي وثاب إلى ذا وذا *** ليس يرى شيئا فيأباه
يهيم بالحسن كما ينبغي *** ويرحم القبح فيهواه
لقد كان طموحه أن يصبح عالما مشاركا مثل أساتذته الذين أخذ عنهم، وزاد هذا الطموح بمطالعاته التاريخية التي استطاع من خلاها أن يتعرف على كثير من الجهابذة لأعلام، سواء منهم السوسيون، أو غير السوسيون، وان إعجابه الشديد ببعض العلماء والصالحين، أمثال: عبد الله بن ياسين، والإمام ابن حزم، والجاخظ، ينم على أن الرجل وهو في ميعة الشباب كان يطلع إلى أعلى المقامات في العلم والصلاح، وكان ينظر إلى آفاق متعددة وتخصصات متنوعة، ودور في التاريخ يؤديه.
وشاءت الأقدار أن يذهب إلى «مراكش»، وهو في سن العشرين، ليوسع من ثقافته ومعلوماته، وليستمع إلى أساتذة آخرين، وكان في طليعتهم المحدث الأشهر شعيب الدكالي الذي كان بالنسبة له ولغيره «إجالة لباب، وفتحا لباب آخر»، وهكذا رأى في دروسه أستاذة الجديد، وما خلب لبه، وأطار صوابه، فصمم أن يرتوي من معينه، ويحتذي حذوه في إملاء الحديث الشريف، والغوص على أسرار التشريع، والتمسك بهدي القرآن والسنة، ورمى الأفكار الجامدة التي ما نزل الله بها من سلطان، ومقامة الخرافات والأوهام التي كانت عالقة بكثير من الأذهان.
ولما قدر له أن يزور «فاس»، ويستقر فيها، انقلبت أفكاره ظهرا على عقب، وتطورت شخصته تطورا ظاهرا، فصار كما قال عن نفسه: «فبدلت أخلاقا غير التي عهدت من قبل وأنا في مراكش وأحواز مراكش، فقد تلقحت في جو فاس بما لم أتلقح به، ولما كانت لي فكرة، ولا تحركت بي همة، ولا نزعت بي نفس عزوف تقول بملء فيها:
لي همة عالية فذة *** طموحها ليس له منتهى
لو ملكت كل الثرى لاعتلت *** إلى امتلاك سدرة المنهى
لقد أثرت عليه «فاس» بجوها ودروسها وشيوخها وصداقتها، فوجد نفسه فيها ما كان يفتقده، وجد فيها العلماء الأعلام، والطلبة المجدين المتفتحين، والأفكار السلفية الصافية، والروح الوطنية المتأججة، وكل ذلك كان يتطلع إليه، فإذا ما كان ارتوى من معين أساتذة متبحرين في الأدب القديم، وإذا ما كان هام بالجاحظ وابن عبد ربه والمقري وأضرابه، فإنه الآن أمام سيل من علماء وأدباء من صنف جديد، إنه إمام محمد عبده، ومحمد فريد وجدي، وشوقي، وحافظ إبراهيم، والمنفلوطي، وخليل مطران، ومن في طبقتهم، يتغنى بأشعار الشعراء منهم، ويتأثر بأفكار المصلحين المجدين فيهم، إنه إمام ثورة فكرية عارمة، استجابت لها نفسه الطموح إلى الكمال، إنه إمام تجديد في فهمه للثقافة وللأدب وحتى الدين، فليس الدين مجرد عبادات، وأداء مناسك، ومجاهدة للنفس، ولكنه بالإضافة إلى ذلك عمل متواصل لصالح الوطن، ودفاع مستميت عن العقيدة السمحة، وتخطيط سليم للحفاظ على لغة القرآن، واعتزاز كبير بحضارة البلاد وقيمها وماضيها المجيد، ومقاومة قوية للوجود الاستعماري بكل الطرق الممكنة.
لقد تغيرت مفاهيمه عن الحياة في فاس، فأصبح يفكر التفكير العلمي، ويؤمن بضرورة العمل لصالح بلاده، سواء في الناحية العلمية التي لا تخفى ضرورتها في بقاء الأوطان، أو في الناحية السياسية التي لا بد من خوض معمعتها لتطهير البلاد من الاستعمار.
وهكذا كان مع جماعة من إخوانه في فاس، ينظم جماعة ثقافية يترأسها، تسمى «الحماسة»، ويشارك في تأسيس جماعة سياسية يترأسها الزعيم المرحوم علال الفاسي، رغم أنه كان أصغر الجماعة سنا.
وصارت الجماعتان تقومان بواجبهما، تؤديان رسالتهما، فمن إلقاء دروس في المدرسة الناصرية وغيرها إلى بث الأفكار الإصلاحية، ونشر الوعي بين جماهير الطلاب، ومن مطالبة بإصلاح المنهج الدراسي في القرويين، إلى مقاومة الأفكار الخرافية والشعوذة، التي كان يتزعمها بعض الخرافين، وكان «مختارنا» يقوم بواجبه مع إخوانه العاملين، يعطي الدروس، ويستحث الذمم، وينظم القصائد، يكثر من الاتصالات، ويشجع كل وسائل النهوض، وكان من مشاغله الأساسية منذ مطلع عمره، إلى أن أدركته الوفاة، الدفاع عن لغته العربية، ومكافحة كل أنواع الاستعجام، واستنهاض الهمم لنشر العلم والمعرفة، وتأسيس المدارس وتشييدها.
لقد ألقى وهو بفاس إذ ذاك قصيدة جاء فيها:
بأي خطاب أم بأي عظات *** أوجه وجه العشب نحو لغاتي
بأي فعال أم بأية حكمة *** أنشرها بين أعظم نخرات
وكيف وأني ألاهي وإنني *** عييت وأعييت حيلتي وأداتي
فأي لسان أرتضيه لنشرها *** وألسننا صيغت من العجمات
تركنا بها كنزا نفيسا فأقبلت *** على غيرها الأفكار مبتدرات
نمد أكفنا – قطع الله راحها- *** إلى غيرها من اللغى السمجات
ونترك منها روضة تخلب النهى *** بطلعتها المخضلة الزهرات
فلو أننا نلنا من العقل ذرة *** ونالت طوايانا أقل حياة
وأمعن كل طرفه في أصوله *** وأنعم في أحواله النظرات
رابنا جميع العز تحت حباتها *** بها يرتقي الشعب الدرجات
ففي غيرنا لو كان فينا مفكر *** عظات ولكن أبن العظات
سأستعجم الأعواد في كل مجمع *** وأستطلع الأفكار في الخلوات
وأسبر أغوار الرجال وأفتلي *** عقول جميع الناس في الجلسات
وأعرض في كل الذين أراهم *** خطابي وابدي بينهم حسراتي
وأدعو إلى رأي وأعلن أنه *** نجاة لمن يبغي طريق نجاة
إلى أن يواتيني الزمان فألتقي *** نجاة لمن يبغي طريق نجاة
ويقول في قصيدة جعل عنوانها: الهلاك ولا الجهل:
حتى متى شعبي يعبده الجهل *** كأن لم يكن قطب السيادة من قبل
كأن لم يكن يوما مديرا لتلكم الـ *** ـممالكيك يحمي ما يشاء ويحتل
كأن لم يكن الشعوب محكما *** إذا قال يحني الرأس من رأسه يعلو
إلى أن يقول:
أجل؛ إننا كنا وكنا وهكذا *** يقول لسان العلم من قوله القول
نشاهد ما يرفض قلبك حسرة *** فكل لوعة تذكو وكم زفرة تعلو
وكن إذا ألقيت يومك نظرة *** عليه ويستذري الدموع فتنهل
لتسقط على الأرض السماوات ولتقم *** قيامة شعبي فالهلاك ولا الجهل
إنها فترة حماسة في تاريخ أستاذنا المختار، وجهت حياته وأعماله كلها في المستقبل، وجعلته يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، سواء وهو بفاس، أو بعد انتقاله إلى الرباط، أو بعد استقراره الثاني بمراكش.
لقد كتب عن هذه الفترة من حياته، يقول: «ثم لما أبت من فاس، وقد ألمت بالرباط حيث احتفظت أيضا علوما وفهوما وأنظارا وبحوثا، لم أقع إلا في الرباط، وفي مشايخ الرباط حللت بالحمراء وقد ألقيت فيها مرساتي، وأنوي أن أقضي الواجب على ولوطني ولشعبي، ما بين تلميذ يهذب وبين درس إرشاد يلقى، وأنا في جانب ذلك أناغي اليراع، فيما عيسى أن يرجع من شأن هذه الأمة، من إحياء ما اندثر من آثار ماضيها، ومن المحافظة على العربية الفصحى التي أراها إذ ذلك في انهيار، ففي هذه الميادين الثلاثة قضيت أزمانا تكشفت عن أعمال كان فضل الله على فيها عظيما».
لقد تغيرت اتجاهاته في فاس تغيرا ملموسا، عبر عنه في شعره وكتابته، وأكده فيما كتبه من مذكرات.
ولقد كانت مرافقته للجماعة الوطنية الأولى ذات تأثير عليه، وكان حضوره في الدروس التي كان يلقيها العلامة المصلح الكبير والداعية السلفي الشهير الفقيه سيدي محمد العربي العلوي الذي كان يقول عنه أنه «موقظ الهمم»، كان حضوره في دروس ابن العربي مدعاة لمراجعة تفكيره فيما نشا وتربي عليه من أفكار ومعتقدات صوفية، فأصبح مع صوفيته وطنيا في نظر مترجمنا المختار، وفي نظر الرعيل الوطني الأول، وليست كما يتصورها بعض المحدَثين المقلدين لكل ما أتى من المغرب مطلق تعلق بالوطن ودفاع عنه، ولكنها مع ذلك مرتكزة على دعامتين أساسيتين: الدين والأخلاق، هاتان الدعامتان كانتا تتجليان في الجماعة الوطنية الأولى التي كان أفرادها كما يصفهم في كتابه (الإلغيات) نخبة في العفة والدين.
وهكذا تلاحظ أنه استجمع الشروط التي تؤهله لأداء رسالته في الحياة، وصار يفكر عمليا في أداء هذه الرسالة، لقد حصل على ثقافة واسعة في مختلف العلوم التي كانت تدرس، سواء بسوس، أو مراكش، أو فاس، أو الرباط، ولقد احتك بالعلماء والمصلحين والشباب الطموح إلى المجد والرقي، ولقد اعتمد على نفسه ومطالعته في إدراك ما كان يفتقده في المناهج الدراسية، فلم يبق أمامه إلا أن يتكل على ربه ليؤدي واجبه نحو دينه ووطنه وشعبه كما التزم بذلك في قرارة نفسه.
لقد كان يقول وهو يتحدث إلى إخوانه ورفقائه: إنه خلق للعلم، ولم يخلق لغير العلم، وهو دينه يطلب منه أن يكون أكثر من معلم، ألم يقل الرسول الأمين الذي يعتبر الأسوة الصالحة له ولغيره من المصلحين الصادقين: «إنما بعثت معلما»، فليتكل على الله، وليذهب إلى مراكش ليؤسس مدرسة تصنع الرجال، وتربي المناضلين، وتكون المنافحين عن لغة الضاد.
لقد قصد الزاوية التي أسسها والده المرحوم بباب دكالة، وجعل منها نواته الأولى لتعليم الأطفال والشبان، وتربيتهم وتكوينهم على أساس من التعلق بالمبادئ الإسلامية المثلى، وإذا ما قلت إنه كان يربيهم التربية المثلى، فإني أعني ما أقول، إنه لم يؤسس مدرسة مثل بقية المدارس، ولكن مدرسته كانت فريدة في بابها، فكان الذين يقصدونها من المراكشيين وغير المراكشيين يأخذون زيادة على الدروس العلمية المعهودة، دروسا أخرى في الصبر على شظف العيش، وتحمل المتاعب، وأداء الواجبات الدينية في أوقاتها، وتمضية أغلب الأوقات في المطالعة والمراجعة، لقد كان نظامها يشبه النظام العسكري، فالانتباه من النوم يكون قبل الفجر باستمرار، والنوم بعد الصلاة، والنوم بعد صلاة العشاء بقليل، واليوم كله درس ومراجعة ومذاكرة، والمختار مع تلامذته في كل الأوقات يعطي الدروس العلمية، ويعطي الدروس بالمثال والأسوة الصالحة، لا يتميز عنهم في شيء، لا في مأكله، ولا في مشربه، ولا في أي شأن من شؤونه.
ويتراءى لي أن نشوءه في وسط طرقي، باعتبار أن والده كان شيخا مربيا، أثر عليه كثيرا في مختلف أطوار حياته، سواء في هذه المرحلة التي نتحدث عنها، أو فيما سيأتي من مراجل، وهكذا أراد أن يجعل من مدرسته زاوية فيها المريدون من تلامذته مثل ما كان يفعل والده المرحوم، كما يتراءى لي أن اعتزازه العظيم بأحد العظماء الذين أنبتتهم (جزولة) -وهي المنطقة التي كنب عنها وتحدث عنها كثيرا-، وأعني به مؤسس الدولة المرابطية وزعيمها الأول عبد الله بن ياسين، الذي كان يلقب بصقر سوس. إن اعتزازه بعبد الله بن ياسين وإعجابه بالأعمال التي قام بها، والطريقة التي سلكها في المراحل الأولى قبل تأسيس دولة المرابطين، جعلته يقلده في طريقة التكوين، والحرص على التربية، حتى يستطيع أن يكون جماعات يخوض بها معركته ضد الجهل والانحراف، ونشر المبادئ الإسلامية، وصيانة اللغة العربية من كل دخيل، وإحلالها المقام اللائق بها في ربوع هذه البلاد.
ومن جهة أخرى؛ نلاحظ أنه كان معجبا كل الإعجاب بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ومن المعروف عن هذا الإمام ولعه بتكوين الفئات من الشباب التكوين الصحيح، وإعدادهم السليم، ليقوموا بواجبهم في تغيير الأوضاع، وإصلاح الأحوال.
ولقد أصبحت مدرسته أو زاويته مقصد الكثيرين من الشبان الذين يتواردون عليها، حتى أخافت الاستعماريين وأذنابهم، فصاروا يدبرون له ولها المكائد، وصاروا يفكرون في إغلاقها بكيفية أو بأخرى؛ لقد عرضوا عليه الوظيف ليترك مدرسته، فأجابهم: «إنما أنا رجل دين وإرشاد عام كما كان والدي، ولا غرض لي فيما يحولني عن ذلك»، فلما أدركوا أنه ليس من أولئك، كشفوا عن حقيقة ما كانوا يرمون إليه، فقرروا نفيه الأول، والامتحان الذي لابد منه لمن يريد أن يؤدي أية رسالة سامية في الحياة.
كان نفيه أواخر سنة 1355هـ (1936م) بداية مرحلة جديدة في حياته، فبعد غياب عشرين سنة قضاها في تنمية ثقافته وتنويعها، واكتشافه آفاقا علمية في مراكش وفاس والرباط، وربطه اتصالات محكمة مع رفقة صادقين، وإخوة مكافحين، ها هو ذا يعود إلى مسقط رأسه (إِلْغ)، الموطن الذي قضى فيه زهرة طفولته، وبداية شبابه، فيتذكر حياته الأولى، وينطلق لسانه قائلا:
إليكم بني أمي أئيب ركائبي *** فيا ليت شعربي هل أنا غير آئب
فقد غبت أحقابا طوالا وها أنا *** أعود كأن لم أغذ قط بغائب
ذا صدفت إلى ما كان ميلي إليكم *** ورجعاي هذا اليوم إحدى العجائب
كأن لم يكن (إِلغ) بلادي التي بها *** سموت به فوق الذرى والمناكب
إلى أن يقول في قصيدته الطويلة:
راينا المعالي كلها في مرادها *** فطرنا إليها بالنفوس الرواغب
فغادرا (فغادرا (إلغا والشبيبة غضة) *** ووجهي وغصني مثل أبيض قاضب
أريغ العلا بالنص في كل فدفد *** تضل به الخريت شتى المشاعب
أعرض حر الوجه نحو سمومه *** فيكسوه من أثواب غرايب
فجئت الجبال الشامخات وخضخضت *** سراب البطاح هوج ركائبي
فخيمت بالحمراء حينا وسابقت *** من أبناء فاس آونات سلاهبي
وطورا أراني في الرباط قد طمت *** على غيوث الهامعات السواكب
فأفرغت في هاتي وتلك وتلكم *** جهود مجد في التفوق راغب
لقد أراد بهذه القصيدة الشعرية أن يخاطب (الإلغيين) بلغتهم العربية القحة التي كانوا متمكنين منها حق التمكن، وقصده كما عبر عن ذلك بنفسه أن يفتح الباب بينه وبين أدبائهم وعلمائهم ومثقفيهم، و(إلغ) إذ ذاك مثل بقية بلاد جزولة، منبت فحول الشعراء، وموطن العلماء المحققين، وهكذا انثالوا عليه بقصائدهم وأشعارهم ومساجلاتهم، فاندفع يجيب كل واحد منهم بقصيدة من نفس الوزن والقافية التي ترد عليه بها القصيدة، وهكذا كيف حياته الجديدة بالمنفى تكييفا جعل منفاه نعمة على (سوس)، بل على تاريخ المغرب كله، فبسبب هذا المنفى، وبسبب بعده على زخارف ومغريات الحياة الحضارية في المدن، استطاع أن يؤلف ما يناهز خمسين جزء عن علماء سوس، وأدبائها، وأخبارها، ونوادرها، وعن حياتها الاجتماعية، وحرفها، وأعيادها، وأمثالها…
وكتابة المختار السوسي عن (سوس)، كتابة رجل وطني مسلم عربي مغربي وحدوي، يقصد التعريف بجزء من وطنه أتاحت له الأقدار أن يكتب عنه ما بم يستطع غيره أن يفعله، ولو قدر له أن يعيش ي جزء آخر من المغرب ليكتب مثل ما كتب عن سوس، فهو لا يفرق بين سوس وبين تافيلالت، ولا بين جبال الأطلس وسهول دكالة والشاوية أنه كما يقول: «من الذين يرون المغرب جزء لا يتجزأ، بل يرى العالم العربي كله، من ضفاف الأطلس إلى ضفاف الرافدين، وطنا واحدا، بل يرى جميع بلاد الإسلام كتلة متراصة من غرب شمال إفريقيا إلى أندونسية، لا يدين بدين الإسلام الحق من يراها بعين الوطنية الضيقة التي هي من بقايا الاستعمار الغربي في الشرق، وكدليل عملي على تجرده ن الفكر العنصري البغيض كان يجمع مواد الكتاب عن مراكش في عصرها الذهبي، يسجل فيه الدور الذي قامت به هذه المدينة الأصيلة في مجال السياسة والعلم والأدب والاجتماع، ولكن ظروف نفيه حالت بينه وبين تحقيق ما كان يطمح إليه، إنه ينادي مطالبا الكتّاب والمؤرخين أن يكتبوا كل واحد عن الناحية التي يوجد فيها، فيعرفون برجالها وأحداثها وعوائدها، فهو يقول: «فليسمع صوت هذا السوسي كل جوانب المغرب من أعظم حاضرة إلى أصغر بادية، فلعل من يصيخون يندفعون إلى الميدان، فنرى لكل ناحية سجلا يضبط حوادثها، ويعرف برجالاتها، ويستقصي عاداتها، فيكون ذلك أدعى إلى وضع الأسس العامة أمام من سيبحثون في المغرب العام على منضدة التاريخ المغربي العام».
إنه يعتبر الوطنية الضيقة خيانة للفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية؛ فالإسلام أذاب كل الأفكار العنصرية الخبيثة وقضى عليها، واعتبر المسلمين أينما كانوا، وحيثما حلوا، أمة واحدة، متلاحمة، لا فرق بين أبيضها وأسودها، ولا بين عربها وبربرها إلا بالتقوى والعمل الصالح، فليفهم هذا دعاة العنصرية الضيقة الذين يتأثرون لدعايات الاستعماريين والصليبيين والذين يريدون أن يثيروا داخل بلادهم قلاقل مفجعة، وأحقادا دفينة، وتطاحنات لا مصلحة فيها إلا للمتربصين للمغرب، العاملين على القضاء عليه، مستعينين ببعض الأجانب الصليبيين الذين يبذرون الفتنة والتفرقة، ويشجعون الأفكار العنصرية المقيتة حقدا على الجماعات الإسلامية المتماسكة، وتقوية لخطتهم الصليبية الجهنمية.
لقد أعطى سيدي المختار المثال الكامل على أن انتماءه لسوس الحبيبة إلى قلبه وقلوب كل إخوانه في المغرب، لا بمكن مطلقا أن ينسيه انتماءه لوطنه وعروبته وإسلامه، وبذلك سد الطريق أمام المتلاعبين بالأفكار، الداعين إلى التفرقة، العاملين للتشتيت.
تسع سنوات قضاها في المنفى، كان فيها مثال الرجل الواعي بمسؤولياته، المنكب على الدراسة والتأليف، المتتبع ولو من بعيد للأحداث التي تقع في بلاده، والتي أصبحت تتوالى بعد منفاه، فمن مطالبة بالحريات العامة، وتحقيق المطالب، إلى الاحتجاج ضد مشاركة الاستعماريين في تقرير مصير البلاد، ومن المظاهرات الصاخبة في الشوارع، إلى محاكمة الوطنيين، وملء السجون بالمعتقلين والمنفيين، ومن إعلان الحرب العامة الثانية، إلى الهزيمة الشنعاء التي عانت منها فرنسا بالذات.
لقد كان يتابع كل ذلك عن كثب، وإن لم يشارك فيه بالفعل، لأن المنفى حال بينه وبين ذلك من جهة، ولأنه اختار أن يواجه الاستعماريين عن طريق نشر العلم والتربية من جهة أخرى.
لقد استأذن الحاكم الفرنسي ذات مرة أن يزور بعض مريدي والده بتادلة، فأذن له بذلك، ولكنه اغتنمها فرصة، فقصد الدار البيضاء، متنكرا، وصادف الحال أن كان ظرف المطالبة بالاستقلال، والتطورات التي حدثت بعد تقديم وثيقة الاستقلال إلى جانب جلالة الملك المرحوم محمد الخامس، فصار يتتبع الأحداث عن كثب، ويستجمع المعلومات، سواء بواسطة الجرائد القليلة التي كانت تصدر، أو بواسطة بعض تلامذته الذين كانوا يأتونه بالأخبار، ولما علم أن فرنسا ركبت رأسها واختارت طريق العنف والسجن والمنفى والقتل، فألقت القبض على أحرار الوطنيين، ونفن الأمين العام لحزب الاستقلال إذ ذاك المجاهد الحاج أحمد بلافريج قال عظيمة حدثنا عنها أحد تلامذته البارين هو الأستاذ محمد الروداني في المقدمة التي وضعها (إيليغ قديما وحديثا)، قال المختار: ««قد قضى الأمر تفرقعت القنبلة، فقد كانت فرنسة تحاول أن تخلق بين المغاربة من يقبل أن يفاوضها على شيء مما دون الاستقلال، كبعض الإصلاحات الداخلية، أما الآن وقد قيلت كلمة الاستقلال، فكل من قبل أن يتفاوض على ما دونها سيراه الشعب المغربي خائنا استعماريا، ولكن إذا قتل الفرنسيون الحاج أحمد فسيتأخر استقلالنا كثيرا، أما إذا أعماهم الله عنه فتركوه حيا، فإن الاستقلال لن يتأخر أكثر من عشرين سنة.
وشاء الله أن يعمي الفرنسيين واستجاب سبحانه لدعوات المؤمنين، وتضحيات المجاهدين الصادقين، فتحقق الاستقلال بعد إحدى عشرة سنة من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وحقق الله وعده، ونصر عباده، وهزم الاستعمار وأذنابه وحده.
ورجع الحاج أحمد وإخوانه من منافيهم وسجونهم ليواصلوا المعركة، ويدافعوا عن وحدة البلاد وثقافتها ولغتها وحضارتها وقيمتها، وكان مترجمنا من جملة الذين أفرج عنهم ليواصل معركته في نشر الثقافة والعلم وتكوين الأجيال، وتوطدت العلاقة ينه وبين محمد الخامس نور الله ضريحه، فعينه في وفد الحج الذي قصد الديار المقدسة سنة 1365هـ، كما عينه في عضوية وفد أحباس الحرمين الذي قصد تونس سنة 1367هـ.
وبمناسبة ذهابه في وفد الحج أذكر أنني التقيت معه قبل سفره، فحمّلته رسالة خطية طلبت منه رحمه الله أن لا يفتحها إلا ساعة مواجهة الحضرة النبوية الشريفة، والسلام على الرسول الأمين عليه السلام، كانت الرسالة خطابا روحيا وتحية حارة، وتعبيرا صادقا عن تعلقي المتين بالجانب النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
بعد رجوعه من منفاه إلى (إلغ)، استقر بمراكش للمرة الثانية، يؤدي رسالته العلمية، سواء عن طريق مدرسته، أو عن طريق الدروس التي كان يلقيها في المساجد، وفي تلك الأثناء قامت بالمغرب بتأييد من جلالة محمد الخامس نهضة علمية، تجلت في الإقبال على تأسيس المدارس العربية الحرة في مختلف أنحاء البلاد، وهكذا تأسست لجنة بمراكش ترأسها مترجمنا، فعملت على بناء مدارس محمد الخامس (بني دغوغ)، ثم ترأس مكتب الجمعية الخيرية الإسلامية بنفس المدينة، وهكذا أقبل يعتم كما هو شأنه دائما بالناحية العلمية والثقافية والخيرية، معتقدا أن تكوين الأجيال وتثقيفها أساس بناء كل نهضة، ومؤكدا أنه رجل علم لا رجل سياسة، ولكن انكبابه على نشر المعرفة وتثقيف الأذهان لم يرض رجال الاستعمار، وجاء ذلك أعقاب الأزمة التي أدت إلى إلقاء القبض على قادة الحزب، ونفي جلالة الملك وأسرته الكريمة إلى جزيرة (مدغسقر)، حتى كان من جملة الذين امتدت إليهم أيدي الاستعمار فنفي إلى (أغبالو ن كردوس) مع جمهور غفير من إخوانه في المبدأ والعقيدة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن بدت طلائع الانفراج المنبئة بتحرير البلاد واسترجاع الاستقلال، ورجوع صاحب الجلالة الملك إلى عرشه، حاملا الاستقلال في يد، والديمقراطية في اليد الأخرى، ومرددا قول البارئ تعالت قدرته: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ).
وانغمر الأستاذ المختار فيما انغمر فيه إخوانه في العمل لبناء الاستقلال وتشييد الدولة المستقلة الحرة والموحدة، ورغما من أنه كان يكره الوظيف، ويعتبره عبودية، فقد أبت عليه وطنيته الصادقة إلا أن يقبل تعيينه وزيرا للأوقاف، ثم وزيرا للتاج.
والمختار السوسي في وظيفته كوزير، لا يختلف مطلقا عن وظيفته كمعلم؛ فحياته هي حياته، وأخلاقه هي أخلاقه، وتواضعه هو تواضعه، لم يغره الوظيف، ولم يستكن للرفاهية التي طالما كانت سببا في انتكاس رجال على أعقابهم، بل بقي صامدا في أحلاقه، ثابتا في عقيدته، منافحا عن مبادئه، مقبلا على كتاباته وتآليفه، زائرا لأصحابه وخلانه، مذاكرا لهم في كل ما من شأنه أن ينهض بهذه الأمة، ويرفع من مكانتها ويقيها من العثرات، وإن أنس فلم أنسى أياما أكون جالسا بمكتبي فيرن جرس الهاتف لأستمع فيه إلى صوت أستاذنا المختار بنبرته السوسية الخاصة، التي يمد فيها على الواو من (أبو بكر) مدا زائدا، ليخربني بأنه سيزورني بالمدرسة أو بالبيت، فلا تمضي إلا دقائق حتى يكون عندي، ليعلق معي على أحداث، أو ليستفسر عن وقائع، أو يلاحظ على قرارات، وفي هذا المجال لابد أن أثبت هنا أنه يرحمه الله زارني ذات يوم بالمدرسة ورجا مني أن أذهب وإياه إلى ساحتها، فقبض على أصابع يدي يفركها فركا – لقد كان حديثه في هذه المرة حول التعليم وتأسيس المدارس بناحية سوس، متسائلا ومتألما في الوقت نفسه لماذا نعمل في عهد الاستقلال ما لم تستطع فرنسا أن تقوم به في هذه الاستعمار؟، لماذا نقوم بنشر اللغة الأجنبية (الفرنسية) لأبنائنا في سوس بعد أن كانت اللغة متقلصة في عهد الاستعمار؟، أليس نشرها في تلك الأصقاع سيكون على حساب اللغة العربية التي كان لها شأن وأي شأن في مدينتنا وقُرانا السوسية، فنبدلها الآن باللغة الأعجمية؟، ما هي مصلحة أبنائنا الصغار في هذه الازدواجية التي ستضيع عليهم معرفة لغتهم، وتقلل من اهتمامهم بدراسة دينهم وقرآنهم؟، لقد كان متألما حقا من هذا الحماس الذي أعطاه عهد الاستقلال للغة المستعمر.
وكان يرى أن (سوس) يجب أن تبقى حصنا حصينا للغة العربية والعلوم الإسلامية، تدرس فيه جميع الفنون المتعلقة بها، سواء منها العلوم الأدبية على اختلافها وتنوعها، أو العلوم الشرعية على تعدد مناحيها الفقهية والحديثية والتفسيرية.
لقد كان يريد أن تتمتع (سوس) بمدارس مثل المدارس التي كانت في عهدها السابق، فيتخرج منها أمثال الشخصيات التي ترجم لها في كتابه الضخم (المسعول) و(سوس العالمة) وغيرهما، وكان يريد أن يبقى السوسيون معتنين بالعلوم التي كانت تدرس عندهم، والتي عددها في كتابه (سوس العالمة)، فبلغت واحدا وعشرين علما، بما فيها علوم المنطق، والهيأة، والفرائض، والحساب، والطب، زيادة على علوم الآلة ولتفسير والفقه والحديث.
وكان يرى أن اختصار البرامج وتغييرها سيضعف ويقلل من نشر هذه العلوم بدل أن يقويها، وهكذا تتضاءل خاصية (سوس) العلمية والدينية.
ولكي نتبين ما كان يشير إليه، نرجع إلى كتابه (سوس العالمة) الذي يتحدث فيه عن النهضة العلمية في سوس خصوصا ابتداء من القرن التسع الهجري، حيث يقول: «جاء القرن التاسع بفاتحة خير، وطلع بفجر منير، وأسفر عن وجه يقطر بشاشة وبشرا، حقا كان القرن التسع قرنا مجيدا في سوس، ففيه ابتدأت النهضة العلمية العجيبة التي رأينا آثارها في التدريس والتآليف، وكثرة تداول الفنون، وقد تشاركت (سملالة) و(بعقيلة) و(رسموكة) و(أيت حامد واقا) و(الجرسيقيون) و(الهشتوكيون) و(الوادنونيون) و(الطاطائيون) و(السكتانيون) و(الراسلواديون) وغيرهم فيها، ثم جاء القرن العاشر فطلع بحركة علمية أدبية أوسع مما قبلها، تشده كل مطلع، فقد خرج العلماء إلى الميدان الحيوي والمعترك السياسي، فشاركوا في الأمور العامة، واستحوذوا على قيادة الشعب، كانوا سبب توطد الدولة السعدية، ثم جازتهم هي أيضا بدورها، فكان منهم أفراد بين الكتاب والشعراء الملازمين للعرش، والسفراء، ورؤساء الشرطة، وقواد الجند، والحرس الملكي الخاص، فزخرت سوس علما بالدراسة والتآليف، والبعثات تتوالي إلى فاس ومراكش وإلى الأزهر، فكانت تؤوب في ذلك العهد بتحقيقات اليسيتني والونشريسي وابن غازي ونظرائهم، حتى كان كل ما يدرس في القرويين يكاد يدرس في سوس، وقولة لا تنفج فيها، وإنها لحقيقة ناصعة، يقر بها كل مطلع «وما يوم حليمة بسر».
وبعد أن يتحدث عن التطورات العلمية في عهد الملوك العلويين، ابتداء من المولى إسماعيل، إلى الحسن الأول، واعتناء هؤلاء الملوك بعلماء سوس، واكتظاظ المدارس بالطلبة في جزولة بالأخص، يقول: «ولكن نشاط العالم الجزولي لم ينطو، ولم يذهب عصره، فالمعارف زاخرة، والمدارس طافحة، والبعثات إلى تامكروت وإلى فاس ومراكش، بل وإلى الأزهر أيضا تتوالى، والقبائل ترى كل واحد منها أن من الواجب عليها إشادة مدرسة علمية خاصة بها، يدرس فيه العلم العربي، فتقوم بها بثلث أعشارها، وبأحباس من أثريائها وبأشياء أخرى من صميم أموال بنيها»، إلى أن يقول: «لأن إقامة المدارس وعمارتها بطلبة المعارف وبالتدريس للعلن العربي، صارت ميادين فخر تتسابق إلي كل القبائل، حتى ليكون كبيضة الديك والكبيرت الأحمر أن تجد قبيلة سوسية كبيرة أو صغيرة ليس لها معهد علمي بسيط مشاد بين ظهرانيها».
ومن المعلوم أن العلماء في سوس كانوا هم المرجع في كل القضايا، والفصل في الخصومات، وبفضلهم بقي السوسيون متمسكين بدينهم، ملتزمين شريعتهم، لا يتحاكمون إلى أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، مثل إخوانهم في بقية أنحاء المغرب، خاضعين للشريعة الإسلامية في أحكامهم، راجعين إليها في رفع المظالم عنهم، حتى إن المتظلمين منهم كانوا يعبرون عن تظلماتهم بهذه العبارة التي يقول عنها الأستاذ المختار أنها عبارة مشلحة (أنا بالله والشرع).
لقد كان مختارنا السوسي يعتبر اللغة العربية مقوما أساسيا في هذه البلاد، لا باعتباره اللسان القومي لها فحسب، ولكن باعتباره ركيزة من ركائز وحدة الشعب المغربي، لا تضاهيه إلا عقيدة الإسلام التي صهرت الوحدة المغربية، وجعلت المغاربة جميعهم أمة واحدة متماسكة ودولة واحدة قوية.
لقد كان ألمه شديدا، وحزنه عميقا، عندما لاحظ بعض التفريط في اللغة العربية، وبعض المثل التي حافظ عليها المغاربة طوال تاريخهم، فكتب يقول: «نكاد نعيش الآن على هامش الحياة العادية التي اندفع إليها هؤلاء الذين يملكون ناصية الحياة الاجتماعية بعد الاستقلال، وأعظم ما نهتم له شئآن:
أحدهما: التفريط في المثل العليا التي لا ترسخ في الشعوب إلا بعد جهود قرون، ومتى اجتثت من أي شعب بمثل هذه الاندفاعات العمياء، فإن أبناء ذلك الشعب سرعان ما ينحرفون عن الصراط المستقيم في الحياة.
وثانيهما: التفريط في المحافظة على اللغة العربية وآدابها التي هي شعار المغرب، وكنزه الموروث، المحافظة عليه كلغة رسمية حتى يوم عممت تركيا لغتها في جميع أنحاء العرب، منذ أوائل القرن العاشر الهجري، وليت شعري لماذا كما نحرص على الاستقلال إن لم تكن أهدافنا المحافظة على مثلنا العليا المجموعة في أسس ديننا الحنيف، والمحافظة على هذه اللغة الوحيدة في البلاد، ومعلوم ما للمغراويين والمرابطين والموحدين والمرينيين من تمجيد هذه اللغة، وهي دول بربرية صميمة».
لقد كان يعتبر اللغة العربية اللغة الوطنية الوحيدة والموحدة للبلاد، وهو بذلك يؤكد على ضرورة الحفاظ على هذه الوحدة الوطنية التي تتجلى في اللغة والعقيدة والتربة، ومن هنا نراه يهتم كل الاهتمام بقضية الصحراء المغربية، فيكتب عنها صفحات في كتابه (المسعول)، ويتتبع المواقف التي وقفها الملك الحسن الأول ضد انجلترا عندما احتلوا مدينة (طرفاية) حتى أخرجهم منها، والإمدادات التي كان يمد بها الشيخ ماء العينين عندما كان مقره بالساقية الحمراء، وتوالت هذه الإمدادات للشيخ ماء العينين في عهد المولى عبد العزيز عندما صار يقاوم الوجود الاستعماري في الصحراء، وبعد انتقال الشيخ ماء العينين إلى تزنيت «أرسلت الأسلحة والذخائر إلى الصحراويين من طرف خفي، وعينت شخصيات صحراوية بظهائر شريفة كقواد يملون سلطان المغرب هناك، مما يدل على أن المراد أن يعرف الصحراويون المعينون على قبائلهم من طرف سلطان المغرب، أنهم نوابه في الدفاع عن الصحراء التي هي جزء متم لأرش المغرب».
لقد كان رحمه الله يتابع قضية الصحراء في عهد الاستقلال متابعة الخبير، وكان يعتبر الساقية الحمراء ووادي الذهب وتيندوف وتوات أجزاء لا تتجزأ من الأراضي المغربية، ولقد كتب في جريدة صحراء المغرب، التي كان يصدرها الزعيم علال الفاسي رحمه الله مقالا أثبت فيه بالحجة الدامغة والدلائل القطعية مغربية تيندوف الجزء المقتطع من بلادنا، والملحق ببلاد الجزائر في عهد الاستعمار.
إن الحفاظ على كيان المغرب وذاتيته وشخصيته وحضارته وثقافته من القضايا التي اهتم بها، ونصب نفسه للدفاع عنها؛ فلقد كان يرى أنه سيأتي يوم تحاسبنا فيه الأجيال إذا ما نحن ضيعنا أية قيمة من المقومات التي بنيت عليها ذاتيتنا وسجلها تاريخنا
ولقد كتب يقول: «نحن نوقن أنه سيأتي يوم يثور فيه أولادنا أو أحفادنا ثورة عنيفة ضد كل ما يمت إلى غير آبائهم من النافع المحمود، ثم يحاولون مراجعة تاريخهم ليستقوا منه كل ما في إمكانهم استدراكه».
ولعل هذا ما دفعه إلى أن يتهم ذلك الاهتمام العديم النظير بالتاريخ المغربي عامة، وتاريخ سوس خاصة، حيث كان يرى أن الأمة التي تنسى ذاتيتها وتاريخها وحضارتها، تفقد وجودها، وتذوب في غيرها.
والتجارب التي مرت عليه في حياته، سواء وهو في سوس، أو عندما انتقل إلى مراكش وفاس والرباط وغيرها من الأنحاء المغربية، والاتصالات والعلاقات التي ربط مع كثير من الشخصيات، وبالأخص عندما كان بفاس، جعله كل ذلك يفتح عينيه على كثير من الحقائق، فهو من جهة محافظة كل المحافظة على ما تركه الأجداد من أسس حضارية، وقيم أخلاقية، وتمسك بجوهر الدين، وهو من جهة ثانية أدرك إدراك الخبير أنه لابد من اقتباس ما أتت به الحضارة الغربية الحديثة، ولكن هذا الاقتباس يجب أن يكون في حدود ما يفيد منها لمن يريد أن يساير ركب الحياة، ولعل أخوف ما كان يخافه أن تجرفنا هذه الحضارة المادية التي بعد عهد آبائنا وأجدادنا بها، فنقبل عليها دون تمييز، وننهل منها دون رقيب، وهكذا نضيع من جملة ما نضيع قيمنا وتقاليدنا وعقائدنا وأفكارنا.
إن نشوءه الأول في قرية نائية، بعيدة عن الحضارة والحركة والتأثر بالتأثيرات المختلفة، وانتقاله بعد ذلك إلى جو حضاري جديد يختلف بعض الاختلاف عن الجو الذي عاش فيه لأول وهلة، جعله يدرك أن القدرة على الانتقال من طور إلى طور في الحياة، والتمييز بين الصالح والطالح في هذا الانتقال، لا يستطيعه إلا المتبصرون الواعون، فالحياة الجديدة المتفتحة قد تعمي الأبصار عن رؤية كثير من الحقائق، وقد تنسي الإنسان كثيرا من وجوه الخير.
فلنستمع إليه يصف لنا ما وقع في المغرب بعدما دهمه الاستعمار بخيله ورجله، بحضارته وعلومه المادية، بعوائده وتقاليده، بأفكاره ومذاهبه؛ لقد كتب يقولك «دعم علينا الاستعمار بخيله ورجله، بلونه وفكره، بسياسته ومكره، بحضارته المشعة، بعلومه الحيوية المادية، بنظامه العجيب، بمعامله المنتجة السريعة، بكل شيء يمت إلى الحياة الواقعية، فوقع لنا كما وقع لأصحاب الكهف يوم رجعوا إلى الحياة، فوجدوا كل ما يعرفون قد تغير تغيرا تاما، وحين كان المغرب لقنا حاذقا سريع التطور، مندفعا إلى كل ما يروقه، أقبل بنهم شديد على التهام كل ما في هذه الحضارة الغربية العجيبة، التي تغير على جميع نواحي الحياة، فتحدث من التغيير ما يجرف التقاليد والأفكار، وكل ما يمت إلى العادات، فإذا بالمغرب يتحول في عدد قصير إلى مغرب آخر، يغادر كل ما كان معروفا منه في الأمس، فإذا بأمثالنا نحن الذين كما نعيش في شرخ شبابنا في المغرب المستقل قبل 1330هـ، قد كدنا نكون غرباء في طور شيخوختنا في المغرب المستقل من حديد 1375هـ فقد حرصنا أن لا ننكر إلا ما يستحق أن ينكر، وأن نحمد كل ما يمكن أن يحمد، واجتهدنا أن نساير العصر، وأن نتفهمه فلا ننكر أخذ ما لابد من أخذه من أساليب الحضارة ونمها وعلومها، لأن الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها أنى وجدها، ولكنا مع ذاك نشاهد إسرافا في التحول السريع الذي لم يراع فيه -حسب أنظارنا نحن المسنين- حكمة ما بين التفريط والإفراط، فنحاول أن نجمع بين محاسن أمس واليوم، ناصبين ميزان القسط، فإذا بنا نكاد نكون الآن على هامش الحياة العادية التي اندفع إليها هؤلاء الذين يملكون ناصية الحياة الاجتماعية بعد الاستقلال».
إنه لا يرفض التطور والاقتباس والاستفادة من الحضارة الغربية، ولكنه يرفض الرفض القاطع الاقتباس الأعمى، والإفراط في التقليد، إنه يتألم شديد الألم من هؤلاء الذين امتلكوا زمام التسيير بعد الاستقلال، فلم يستطيعوا أن يفرقوا بين الغث والسمين، ولا بين الصالح والطالح، بل اندفعوا يقلدوا الغرب الاستعماري في كل ما أتى به، وما سارت فيه حضارتهم التي أمحت فيها الحياة الروحية محوا أصبحوا يجنون ثمار آلامه اليوم، لقد قلدوا الغرب الاستعماري في لباسهم، في اختيار تأثيثهم، في حفلاتهم، في عوائدهم، وحتى في مقاييس أخلاقهم، وأذواقهم، وأفكارهم. لقد كانت للمغرب مقاييسه وتقاليده ومعاييره في كل ما ذكر، وفي غيره، فهل عفى الزمان على كل تلك المقاييس؟، وهل ثبت أنها غير صالحة للحياة؟، فلماذا نبدلها هذا التبديل؟، ولماذا نهجرها هذا الهجران؟، إنه وباء التقليد الأعمى الذي لا يفيدنا في شيء، فهل التطور هو التنكر للقيم والمقاييس التي كان عليها الآباء والأجداد مهما كانت صالحة ومفيدة وضرورية للحياة المستقيمة؟، وهل الاقتباس هو أخذ ما أتى به الأجنبي الدخيل مهما كان ضارا، وغير ملائم لديننا وتقاليدنا الصالحة؟، إن التزام هذه الأمة المغربية بدينها الإسلامي منذ القرن الأول الهجري فرض عليها السير في منهاج للحياة لا يمكن مطلقا أن ينحرف عن المنهاج الذي أتى به رسول الإسلام، فالمقاييس والمثل العليا لا تؤخذ إلا من الإسلام، والتحاكم لا يكون إلا للإسلام، والتطور لا يكون إلا في دائرة الإسلام، وإذا كان الإسلام دين العلم والفكر والتقدم والخلق، وإذا كان الإسلام لا يتنكر لكل صالح مفيد أتت به مختلف الحضارات، لماذا نبتعد عن مقاييسه ونستبدلها بمقاييس ومعايير أخرى، إن هذا هو الخسران المبين.
إن شخصية المختار السوسي متعدد الجوانب، ولكن الطابع الذي غلب عليه، هو الطابع العلمي الأدبي التاريخي، فهو عالم باحث أديب مؤرخ، وهو كاتب شاعر مؤلف، وهو مع ذاك سلفي موجه، تأثر بصوفية والده، فكان لها انعكاس على حياته، وأعجب بسلفية أستاذيه الدكالي والعلوي، فسار على نهجيهما في مقاومة البدع المنكرة، التي تخالف جوهر الدين، ولا تتلاءم مع قدسيته ونصاعة مبادئه وحقيقة دعوته التوحيدية.