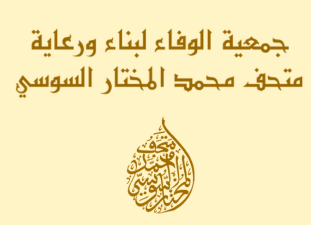المملكة المغربية
رابطة علماء المغرب
فرع إقليم تزنيت
كلمة الأستاذ محمد العثماني
أدب محمد المختار السوسي
تزنيت 10 و 11 شعبان 1402
الموافق 3 و4 يونيو 1982
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أيها السادة:
لقد اختير لي أن أتحدث عن الجانب الأدبي لدى الأستاذ محمد المختار السوسي ضمن جوانب شخصيته المتعددة ثم فكرت طويلا في تجريد المختار السوسي الأديب من المختار العالم، والمؤرخ السياسي والاجتماعي، والمدرس المربي النفسي فاستعصى علي هذا التجريد لأن صفة الأدب تطغى على ما سواها لديه إذ يظهر صاحبها أديبا في كل معارفه وممارساته .. بمعنى أنه أديب وهو يكتب التاريخ وأديب وهو يعالج مشاكل فقه اللغة ومسائل فقه الدين، وأديب وهو يتحدث في المجالس الخاصة والعامة وحتى في فرحه ودعابته البريئة يستعمل الأمثال والنصوص الأدبية القديمة للتنكيت والتمثيل ويستحضر من تلك الذخائر ما يفيد جليسه ومخاطبيه .. أي أنه أديب في ممارسته لأي نشاط علمي أو فكري أو اجتماعي بالإضافة إلى قول الشعر الرصين والترسل الفني في الخطاب والرسالة.
وهنا تطرح عدة إشكالات وأسئلة مثلا:
– هل يكون المؤرخ مؤرخا حقا بلا أدب؟
– هل يكون العالم ناجحا وهو غير أديب ولو في الدرجة الدنيا؟
– وفقيه لغة بلا أدب كيف يكون؟
قد تثير هذه الأسئلة جدلا ونقاشا حادا قد يخفف منه -على الأقل- سؤال وتمثيل كجواب عليه، أما السؤال فهو:
كيف يعبر المؤرخ مقلا عن الأحداث تعبيرا مقبولا ويستخرج منها العبر التاريخية دون أن تكونوا لديه قدرة على التعبير الأدبي موازيا للتفكير العلمي؟
أما التمثيل فهناك مؤرخون ومؤرخون أدباء وغير أدباء، ولكن الأولين هم الذين يقرؤون على العصور ويبقى ما كتبوا على مدار التاريخ مرجعا للباحثين، ومحط الاهتمام من المحترفين والهاوين..فابن خلدون وأبو حيان الأندلسي، وابن الأثير، وابن الجوزي -مثلا- مؤرخون حقا، لأنهم أدباء، وعبد الواحد المراكشي ومحمد أكنسوس، والناصري وابن زيدان…مؤرخون طبعوا إنتاجهم بالتعبير الأدبي والأساليب الفنية تختلف قوة وضعفا لاختلاف أصحابها في التمكن من الأساليب الأدبية والملكة الفكرية..مؤرخ المملكة الأستاذ الكبير عبد الوهاب بن منصور لو لم يكن أديبا لما كان لإنتاجه الغزير في التاريخ سعة الانتشار والقبول.
قد يثار سؤال هنا يتعلق بمثال مقابل أو مضاد ليتضح الإشكال والجواب عليه جد يسير، لأنه يكمن فيما لا يقرأ وهو أكثر مما يقرأ من كتب التاريخ، وفي الضعف البارز في الأداء والصيانة مع حشد النقول بتزنيت أو بدونه، وافتقاد الحركة الفكرية في تضاعيف المادة التاريخية مما نجده عند نقلة الأخبار أو التكراريين” إن أسعف التعبير..
وكمثال نذكر -فقط- كتاب الأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام”.
والسبب يعود إلى أن اللغة مصدر التفكير، أو من أهم مصادره ومن لا يحسن فن التعبير باللغة التي يكتب بها لا يأتي بأفكار جديدة ولو كانت تدور في خلده، أو تستقر في شعوره الباطني، والمؤرخ بلا إضافات مستخرجة من التاريخ نفسه ليس مؤرخا إلا باعتبار أنه يضبط الوثائق، وينقل عن غيره التعاليق.
ومثل هذا يقال في عالم الدين بل هو أوسع مظهرا لهذه الإشكالية سلبا وإيجابا، فالعالم الأديب يكون أكثر إفادة وأقوى عارضة، وأعمق أثرا من العالم المجرد.. لأنه لا يملك أداة التبليغ وهي أسلوب أدبي وتفكير علمي، أو ملكة علمية كما يعبر بن خلدون يتصرف بها في العلم الذي يمارسه، ويستخرج بها الفروع من الأصول.. بل هو نسخة مكررة للكتب التي يحصل عليها كل قادر على الشراء والقراءة، فيستفيد منها أكثر مما يستفيد من عالم له ذاكرة ماسكة يستظهر بها النصوص كما هي، ويلقنها كما هي.
وقد امتلأت ساحة الحضارة الإسلامية بنماذج من هؤلاء وأولئك في عصور التراجع والجر الفكري الإسلامي الخلاق.
وعلى ضوء هذه المقولة نقرأ محمد المختار أديب في جميع إنتاجه، ونعرض إنتاجه على مشرحة البحث الأدبي بصرف النظر عن موضوعه الأساسي ومادته التاريخية أو الإجتماعية أو ما سوى ذلك.
هذه قضية، وقضية أخرى يطرحها هنا كون أديبنا الكبير امتدادا لما كان عليه الأديب المغربي أو العالم المغربي من تمدد الأفق وتعدد ألوان المعرفة، أو ما يعبر عنه بـ “العالم المشارك” أو “الأديب المشارك”.. ومعنى هذا بعبارة أدق أن المثقف المغربي الأصيل عبارة عن دائرة معارف، لا مجرد أفقي أو عمودي، فالتخصص في نظره نقص لأنه آية العجز والقدرة المحدودة، والأمثلة كثيرة ولنذكر منها:
القاضي عياض والحسن اليوسي، وعمر بن عبد العزيز الكرسيفي وعبد الله بن يعقوب السملالي، وحفيده عبد العزيز وكذا أبو زيد الجشتمي، ومحمد بن مسعود البونعماني من المتأخرين – هم مجرد أمثلة لا حصرها، إذ لو حاولنا لكنا من العابثين.
بل لا مفهوم للمغرب في هذه الظاهرة، فأكثر علماء الإسلام الكبار من هذا القبيل، سلكوا لتحصيل ألوان المعارف كل سبيل.
والقضية المطروحة على ضوء هذه الظاهرة هي جواب هذا السؤال:
محمد المختار هل هو مؤرخ أديب أو أديب مؤرخ؟ وهل هو مثلا عالم أديب أو أديب عالم؟
ومعنى هذا أن أصحاب الفكر والعلم والثقافة الواسعة فريقان:
1) أدباء غلب عليهم جانب من المعرفة أو جوانب، كالفلسفة والتاريخ وعلوم الشريعة، فهم فلاسفة أدباء ومؤرخون أدباء.. فابن طفيل أديب اشتهر بالفلسفة، فهو فيلسوف أديب، وليس العكس وابن حزم وابن العربي والسوسي والقاضي عياض علماء أدباء، وابن خلدون مؤرخ أديب لا أديب مؤرخ.. وقد تتقارب الكفتان فيصعب ملاحظة التفاوت.
2) مثقفون غلب عليهم الأدب إلى جانب معارفهم المختلفة والأمثلة متوفرة جدا نذكر منها ابن الخطيب وعبد العزيز الفشتالي ومحمد أكنسوس.. ممن كان لهم إنتاج في التاريخ واهتمام به لكن الأدب بجميع فنونه هو الغالب عليهم، فهم أدباء مؤرخون لا مؤرخون أدباء..
ومحمد المختار في أي إطار هو؟
الجواب واضح، هو أديب مؤرخ، وأديب عالم، أي أن صفة الأدب تظهر على أي لون من ألوان المعرفة التي يتسم بها.
أيها السادة:
توخيت عرض هذه الأفكار بهذه البساطة، وتجنبت التقعير وأساليب “الموضة” لأمهد بها للموضوع الذي بين أيدينا.
أدب محمد المختار السوسي بين قديم وجديد.
وقبل تناول الموضوع نذكر بعض المؤثرات السابقة واللاحقة في تكوين شخصية أديبنا من ناحيتها الأدبية كأديب وشاعر..
لقد نشأ أستاذنا في جو مدرسة “إلغ” وهي مدرسة معروفة بدراسة الأدب واللغة، مهتمة بكتبهما منذ تأسيسها على يد الأديب العصامي الشاب محمد بن عبد الله الإلغي المتوفى سنة 1303 هـ وتعد هذه المدرسة حقا في طليعة المدارس التي كانت تخرج الأدباء واللغويين قبل أن تخرج من كتب لهم أن يكونوا فقهاء وقضاة نبهاء وكانت لهذه المدرسة فروع، وهي المدارس التي كان المتخرجون من المدرسة الإلغية تصدروا للتدريس فيها، فاتبعوا في الدراسة والمواد منهج المدرسة الأم، وطريقتها في التلقين، واختيار كتب المطالعة الحرة التي يكون لها أثر عميق في تثقيف الطالب وتقويم لسانه وسعة اطلاعه..وأهم هذه المدارس التي سميتها -مع التجوز- فروعا مدرسة إفران التي كان عميدها خريج مدرسة “إلغ” وأنبه تلامذته شيخ الأدباء والشعراء في عصره الطاهر بن محمد الافراني وهو الذي أخذ عنه من جملة من أخذ عنهم الأستاذ محمد المختار.
قال في مذكراته “وقد نفعتني هناك البيئة الإلغية، وكان لمدرسة تنكرت وأدبائها ينبوع لي في ذلك متفجر، على أن لمولاي عبد الرحمن البوزكارني في ذلك ما ليس لغيره في تثقيفي وصقل فكرتي “الإلغيات ج2/ص228.
وقبل أن ينتقل إلى المدرسة الطاهرية كان تلقى مبادئ الفنون على يد أنجب تلامذته مدرسة “إلغ” ونجل مؤسسها الأديب اللغوي الشيخ عبد الله بن محمد المتوفي سنة 1389هـ.
هذا هو الجو الذي نشأ فيه محمد المختار الطالب، وهو جو غلب عليه الطابع الأدبي وأساليب الكتابة الفنية ودراسة الشعر في مختلف عصور التاريخ العربي.
نشأته التثقيفية الأولى إذن كانت في أحضان مدرسة خرجت عشرات من الذين جددوا للأدب دولته أيامئذ، وقامت بهم “عكاظ” الشعر حينا من الدهر، وتأثروا بالأدب الأندلسي خاصة، حتى كان يخيل لمن يقرأ النبغاء منهم أنهم عاشوا في غرناطة الشهيدة فانتقلوا منها إلى ذلك البسيط القاحل الأجرد الذي لا شجر فيه ولا زهر ولا ماء ينساب في مجاريه الفضية ولا طير، ولا مناظر باسمة يستوحيها الشاعر فيصدر عنها بشعر يكاد يسيل رقة وعذوبة، ويفيض عاطفة عاصفة وشعور جياش، ولكن أولئك الأدباء عاشوا مع دواوين الأدب الأندلسي في تلك البيئة الضاحكة فغلب على شعرهم ونثرهم “نفح الطيب” الذي تعشقوه، وكانت لهم منه “دخيرة” وجدانية تغنيهم وهم يعيشون في بيئة عابسة – عن مناظر ضاحكة آنسة.
ليس غرضي في الإشارة إلى هذه المدرسة وما تفرع عنها أن أجعلها مادة في الموضوع، أو ألم بتاريخها وتأثيرها في التكوين الثقافي لجيل من الأدباء والعلماء الذين تخرجوا منها أو تخرجوا عن تلامذتها ولكن الغرض أن نقف -فقط- على المؤثر الأول في تكوين محمد المختار الأديب وتوجيهه منذ مرحلته الأولى في تعليمه، وهي المرحلة التي تكون مطامح الشاب وتلون ميوله، فيتأثر بالجو المحيط به تأثرا يتفاوت قوة وضعفا حسب الاستعدادات النفسية والمواهب الذاتية. ومن هنا ننظر إلى شخصيته الأدبية رابطين بين بدايته كطالب يدرس اللغة العربية وقواعدها، ويلتهم النصوص الأدبية وبين نهايته وهو أستاذ يتضلع في فقه اللغة وآدابها، وينتج الشعر الرائع بقوة وغزارة حتى كان أبرز سماته صفة “شاعر”وإن كان طموحه ومؤهلاته لإقناعه بأن يكون شاعرا وأديبا وكفى، ولكنه أراد -وقد حقق ما أراد- أن يكون عالما كبيرا ومؤرخا موسوعيا وقد عكس نفسه الكبيرة ونظرته العالية إلى أسمى المراتب العلمية مثل قوله:
|
تسف عزيماتي وإن فاقت الشعرى |
*** |
إذا كان وأعلى ما أحاوله الشعـرا |
|
يرى العنب المسكي أزكى حـلاوة |
*** |
عريض قفا ما ذاق في عمره خمرا |
إن تأثره بالمدرسة الألغية بقي ملازما له بالرغم من توافر مؤثرات أخرى كيفت شخصيته مع بيئات جديدة انتقل إليها في مدن المغرب ومراكزه الحضرية، إلا أن الفوارق بين المدرسة -وعلى الخصوص في تأثيرها الأدبي وبين مؤثرات المعاهد في الحواضر ضعيفة جدا، وإذا نظرنا إلى تشبت كلتيهما بالأصالة وتأثرهما معا بالأدب الأندلسي والأدب العباسي في عصره الأخير، ولا نستثني إلا ما طرأ على الأدب المغربي في فاس والرباط من تجديد نسبي وثورة على الجمود الفكري والأساليب التقليدية التي تعوق ولا تروق.
وما دمنا بصدد الحديث عن المؤثرات الأولى في تكوين شخصيته وتوجيهه إلى الوجهة التي انتهى إليها نعود إلى الوراء لننظر إلى محمد المختار السوسي الطفل وهو يتعلم حروف الهجاء ويتلقى مبادئ القراءة والكتابة، ويحفظ السور القصار من القرآن الكريم.
وليس مجرد تعلم حروف الهجاء وحفظ كتاب الله في أي كتاب هو الذي أقصد أن أجعله فاصلا بين حديث وحديث، أو مبدأ مؤخرا في هذا السياق، بل أريد أن أقول متسائلا ما هو الكتاب الذي فتح عليه عينيه؟ ومن هو معلمه الأول؟ يقول علماء النفس والتربية الدرس الأول لا ينسى، وهي نظرية صحيحة، وأصح منها أن المعلم الأول لا ينسى، لأن له تأثيرا قويا في نفسية الطفل وتكوين شخصيته وتلوين ميوله حسب شخصية ذلك المعلم والطابع الذي يضعه على طفله.
ذكرت هذا لأخلص إلى أن محمد المختار الطفل تعلم القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم على يد والدته السيدة رقية بنت العلامة الكبير الشيخ محمد بن العربي الأدوزي، وقد كانت حافظة لكتاب الله عارفة بمبادئ الدين ومسائله الضرورية وفوق ذلك كان والده الشيخ أكبر مرب في عصره ووسطه، فمن الضروري أن يلقن ولده دروسا بالطريقة العلمية وبصورة غير مباشرة عن طريق القدوة، وهي أهم وسيلة في التربية وأعمق أثرا. والدة صالحة، ووالد مرشد، وجد هو شيخ علماء عصره.
لقد قيل كثيرا “أن العباقرة لا ينجبون عباقرة” وهو قول صحيح في غالب الأحوال، ولا يصح في كل الأحوال، وشاع في الأمثال العامية “النار لا تترك إلا الرماد” وهو مثل صحيح إن قصد بمدلوله القول الأول الذي حاول بعضهم أن يبني عليه قاعدة عامة لا تنخرم إلى في بعض أجزائها، ولا ينفلت منها إلا الشواذ.
إلا أن هناك في المقابل قاعدة أخرى تقول “لا ينجب الصالحين إلا الصالحون” لأن الصالح شيء والعبقرية شيء آخر، وقد يشذ عن هذا أيضا أفراد فتنخرم القاعدة، لأن الله تعالى -متى شاء- يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.
ذكرت هذه الفلسفة الاجتماعية التي تهدمها الحقائق وينقضها الواقع في أكثر من حالة، وأنا أوازن بين بداية محمد المختار السوسي في ذلك الجو الحافل بالعلم والصلاح وبين نهايته وهو يتقلب في أجواء مختلف المشارب والأذواق، ثم هو في صلاحه وسلوكه ونهمه إلى المعارف تلقيا وتلقينا لا يتبدل ولا يتحول.
الواقع أن المؤهلات الشخصية وحدها لا تكفي دائما لأن تقود صاحبها إلى قمة المجد ومطلع التألق واللمعان، وآية ذلك أن كثيرا من الذين يظهرون على مسرح الحياة والأحداث في كل مكان وآن، ما كانوا كلهم يملكون من المؤهلات ما يوازي ذلك الظهور ولا أنفقوا في سبيله ما يكفي من السنوات والشهور، ومع ذلك أخذوا بوسيلة أو بأخرى، وفي غفلة من التاريخ مقاعدهم في صف الخالدين، وآية أخرى أن التاريخ يحتفظ بأفراد كانت فيهم مواهب الريادة فعاكستهم ظروف سلبية ما وجدوا معها حيلة ولا اهتدوا سبيلا، فعاشوا وقد طواهم السكون، ثم درجوا كأن لم يعيشوا ليكون منهم ما يمكن أن يكون.
ذكرت هذه الأفكار لأقول أن محمد المختار الطالب في فاس والرباط وجد نفسه في ظروف كان فيها تاريخ الوطن بين قوسين وحملت من الأخطار والنذر ما يهيب بكل شاب غيور على المقدسات التي تدوسها أقدام الغزاة إلى التعبئة في حركة الإنقاذ التي تنتظرها البلاد من أبنائها المخلصين، وذلك ما وقع كما قال في أول قصيدة له آنذاك:
|
شباب المغرب الأقصـى يفـيـق |
*** |
ليحيى المجد والحسب العـريـق |
كان أستاذنا أحد الثمانية أو العشرة الذين تأسست على يدهم الحركة السلفية التي كانت نقطة الانطلاق لهذه الجماعة الشابة التي يجب على الشعب ألا ينسى فضلها وأن يضع لها فصلا مذهبا في مكان بارز من تاريخه.
قال الأستاذ في مذكراته:
وقد أسسنا هناك جمعيتين الأولى جمعية الحماسة التي اتخذني الأعضاء رئيسا لها، والثانية جمعية سياسية سرية أنشأناها في 12 رجب 1344 هـ ورئيسها الأخ علال أصغرنا – الألغيات ج 2ص 227.
لا يذكر محمد المختار الطالب في فاس والرباط إلا تداعت الخواطر فيذكر معه المناضلون الأولون من أمثال محمد علال الفاسي محمد غازي، محمد المكي الناصري، محمد القرى، محمد حسن الوزاني ثم محمد الفاسي والهاشمي الفلالي في آخرين من السابقين إلى الكفاح الوطني، وقد جردت أسماء هؤلاء الأبرار من كل صفة ولقب لأن أسماءهم غنية عن كل تعريف وتحلية، ولأن تاريخهم سيظل منارا تهتدي به الأجيال الصاعدة في دروب النضال، ويتحدى الغوغائيين وهم ينحرفون يمينا ويسارا.
قال في مذكراته يصف أول لقاء صامت بينه وبين علال:
“رأيت شاعرا الشباب لأول مرة شابا نحيلا وهو حاسر الرأس عليه جبة مخططة، وهو إذ ذاك كان ناهز الحلم، وذلك عند قيامنا من درس مقامات الحرير على الشيخ محمد بن العربي العلوي ص 114 ج2 بتصرف. ثم قال … (في فاس استبدلت فكرا بفكر فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز، قد ارتكز على الدين والعلم والسنة القويمة، فجشت بقصائد حية …”
نعم جاش بقصائد حية كما قال بعد ما بهره في فاس والرباط ما كان يقرؤه مع زملائه للشعراء الجدد في الأقطار العربية، فرأى نفسه -وهو الأديب المتذوق- دون المدى الذي يريد، وقد عبر عن أزمته النفسية في مثل قوله:
|
لم لا أقول الشعـر كيـف أريـد |
*** |
وأنا بنيـران الشعـور وقــود؟ |
إلى أن قال:
|
فكري يجيش ومرقمي في أصبعي |
*** |
لم لا أقول الشعـر كيـف أريـد |
كما بهره شعر زملائه الشباب وهم متأثرون بالمدرسة الشرقية الجديدة، وفي مطلعتهم الشاب النحيل، وقد أعلن أنه “شاعر الشباب” في قصيدة حماسية رقيقة كان يجري مطلعها على كل لسان، كأنه مثل سائر من الأمثال:
|
كل صعب على الشبــاب يهـون |
*** |
هكـذا همـة الرجـال تـكـون |
وكان الشهيد محمد القرى من الأدباء الشباب يقول الشعر الرصين وحتى محمد المكي الناصري الذي يميل إلى الخطابة والترسل والبحث العلمي منذ ذلك الحين كان يقول الشعر الهادف في مناسبات، لأن القصيدة والخطبة أيامئذ بمثابة المقالة السياسية والتقرير المذهبي اليوم، وقد توفرت وسائل النثر وتطورت الأساليب.
لا أقصد إعطاء صورة ولو مصغرة للأدب المغربي في ذلك العهد ولكني أذكر فحسب أن أستاذنا الشاعر كان مأخوذا بشعر زملائه وتحررهم من بعض القيود التي كانت تمنع الشعر في المغرب من الانطلاق والسير مع تيار التجديد الذي يصل منه إلى المغرب رذاذ لم يتأثر به إلا هؤلاء الشباب، فلم يخف إعجابه بالنغمة الجديدة فقال – وهو يستغرب أن يكون زملاؤه في مستوى الإبداع أو ما يعتبر إبداعا بالنسبة لتلك الفترة، ويعجز عن اللحاق بهم فيقول:
|
أيـهـز علال وقـرى ومكــي |
*** |
بـشعـرهم السمــا فتـميـد؟ |
ثم جاء مثار الاستفهام والاستغراب بعد بيتين:
|
ويسيـل كـل منهـم متـدفـقـا |
*** |
وأنـا أمـام عبابـه جـلمـود؟ |
كذلك يرسل تأوهاته وأشجانه على كونه يرى نفسه دائما في المؤخرة، وان كان في الواقع مجليا في الحلبة يجرى على سنن ويفوز بالرهان، ولكن كبر نفسه يحرجه دائما ويضعه موضع المتأفف الذي يرى كل نهاية بداية وكل قمة حضيضا، فهو من الذين يعانون “أزمة الغاية” لأن كل غاية بداية أخرى لدى كبار النفوس وعالي الهمم، أزمة الغاية أو ما يعبر عنه بالطموح هي الطاقة التي تحرك عجلة التاريخ، وتدفع أشخاصه لتغيير المجتمعات وبعض أمجادها بإعطاء البديل لا بإحيائها فقط، لأن الذي يصف الأمجاد ويقيم لها الذكريات لا يعدو أن يكون مجرد “محافظ الوثائق” أما الفرد الذي كرر أمجاد أمته عمليا وأعطى لها البديل فهو عضو في التاريخ، لا تعليق على هامش التاريخ.
جاءت هذه الفكرة وقد وقفنا على منعطف سلبي في حياة الأستاذ المختار، ذلك المنعطف الذي رجع عنه مضطرا، حيث رأى بعض زملائه يهاجرون إلى الشرق لاستكمال دراستهم هناك، فصدته عوامل وظروف اجتماعية أن يهاجر في طلب العلم وأخذ تجارب ومعارف جديدة لم يكن المغرب أرضية لها يومئذ ، فبقي يجتر الألم النفسي الذي أصابه من ذلك حتى آخر حياته.
ولنتركه يحكي قصته في مذكراته:
“.. نزلت الحمراء وأنا لا أدري ماذا أصنع، وإنما الذي غلب علي وأثر في تأثيرا شديدا تخلفي عن حلبتي التي التحقت بمصر تستقي من معينها كالأخ المكي الناصري، والأخ عبد الرحمن بن الشيخ الدكالي، والأخ محمد عثمان، فلم أدر كيف أصنع بعدهم ولكن لم تمض لي سنة في مراكش حتى تمهدت تلك الطريق التي يعلم خبرها كل أحد حين قد قدمتني الأقدار أستاذا وأنا أنشد بيني وبين نفسي:
|
خلت الديـار فسدت غير مسـود |
*** |
ومن العناء تفـردى بـالسـؤدد |
هو إذن كان على موعد مع همته للجري إلى تلك الغاية، ولكن حالته الاجتماعية قيدته تقييدا فأعطى لنفسه من نفسه الشرق وجامعاته وأكب على الدرس والتهام ما يأتي من الشرق ومن الغرب حتى وجد نفسه في صف العلماء الذين يزدادون علما بترويج ما عندهم وتنميته في مجالس الطلبة والدارسين.
كان يقول دائما “إنه خلف للعلم لا للسياسة قال ذلك للمواطنين وقاله لزملائه، وقاله لرجال الاحتلال المتربصين به الدوائر، ولكنه كان يعني شيئا وخبراء الاحتلال يعنون أشياء فهم جد أذكياء في هذا الباب وأخطر سياسة في نظرهم أن يكون مواطن من الأهالي على جانب كبير من الجاذبية وقوة الشخصية وثقافة إسلامية واسعة واستقامة في السلوك، أن يكون مواطن بهذه المثابة يتصدى للتدريس في المساجد العامة والمدارس الخاصة، ويفتح أعين الشباب وقلوبهم، مثل هذا المواطن يعتبره الاحتلال من ألد خصومه، ويعبر عنه بالكلمة المهذبة المعروفة:”العدو العاقل”، ولكنه أخطر عدو على الإطلاق.
الاحتلال دقيق الملاحظة، مصيب في نظرته، منسجم مع نفسه وان كان على خطأ جسيم من ناحية أخرى حيث قرر إبعاد الأستاذ إلى قرية “إلغ” ليكون تحت مراقبة الضباط في مركز تفراوت، معزولا عن الناس، وعن الطبقات الواعية على الخصوص..ومن حسن حظ الوطن وبلاد سوس بصورة خاصة أن قدر الله منفاه إلى مسقط رأسه في تفراوت وفي زاوية والده الشيخ..فهناك وجد نفسه وقلمه مجردا من كل شاغل، فانهمك في تسجيل مذكراته، وفي جمع المواد والوثائق حتى تكون من ذلك إنتاج أدبي وتاريخي خصب أحيى به تاريخ سوس وخلد أمجادها العلمية والبطولية في تلك الموسوعات التي يقول لسان حالها للباحثين والمهتمين بالدراسات الجامعية: هذه سوس الأدبية، سوس العالمة، سوس الماجدة، معاهدها العلمية ومراكزها الدينية، أسرها العلمية، بيوتها، بطولاتها، علماؤها وأدباؤها أطوارها الاجتماعية والسياسية، قبائلها ورؤساؤها دورها في حركة تاريخ المغرب وأحداثه القديمة والحديثة…
هكذا بتعبير إجمالي يمكن أن نلخص في حديث مقتضب ذلك الإنتاج الضخم الذي أنجزه وحده في منفاه وفي بضع سنين، وإنجاز مثله ينوء بالعصبة أولي القوة في عشرات السنين.
أيها السادة:
إلى هنا رسمت رؤوس الخطوط لصورة الرجل في إطار حياته العلمية والأدبية والوطنية، وما يكتنفها من تباشير وإرهاصات، وهي خطوط رسم إجمالي مختزل، لأن هذا الحديث يضيق عن الإفاضة والتصوير الدقيق.
إلا أننا نلتفت مرة أخرى إلى حياة محمد المختار الشاعر الأديب المؤرخ لنأخذ له من هذا الجانب ولو صورة مصغرة.
كان الأدب كما أشرنا إليه آنفا غالبا عليه كمثقف، فهو أديب كبير واسع الاطلاع في فقه اللغة والنفوذ إلى أسرارها، وكان في أول اهتمامه بالإنتاج يعني بالقريض، فيأتي بقصائد بين طوال وقصار في مختلف أغراضه التي تروج في الوسط الذي نشأ فيه، ويظهر أنه لم ينتج النثر الفني إلا بعد أن استقر في مراكش أو بعد النفي مباشرة، ولكن لا ننفي أن تكون عنده تجارب عديدة حتى في طور حياته الأدبية الأولى. والتي تنحصر في الرسائل الاجتماعية الإخوانية ومذكرات صغيرة في أغراض شتى.
أما شعره فقد تأثر كما سبق -ضمن مؤثرات أخرى- بالمدرسة الألغية، ولا ننسى أن هذه المدرسة تأثرت كثيرا بالأدب الأندلسي كما قال في أرجوزة يذكر اللون المفضل لدى تلامذتها.
|
متعهـم فـي الأدب الأنـدلسـي |
*** |
لا في الرياحين ولا في النرجـس |
|
فكم قصـــائـد لهـم عصمـاء |
*** |
بيـن بســائط لهـم جــرداء |
|
وطيبهم في عرف “نفخ الطيــب” |
*** |
في وسط ذلك الجـرز الجديـب |
ثم فتح عينه في فاس والرباط على التيار الجديد بعد النهضة الحديثة، فراقه هو زملائه إنتاج أمراء الشعر في المشرق العربي، فمنهم من كاد يقطع صلته بتقليد القديم، مثل شاعر الشباب، لأنه الشاب الصاعد إذ ذاك محمد علال الفاسي، ومنهم من بقي مع محاولاته التجديد على صلة بالقديم مثل المختار السوسي لأنه من أكبر زملائه الشباب سنا، وأغزهم حفظا لنفائس الأدب القديم، وأكثرهم معانة للقريض، ومحاكاة للأصيل، إلا أنه جرى في التجديد أشواطا مع المحافظة على الجذور القديمة واقعا تحت تأثير العوامل السابقة.
لا أعني بالتجديد ما يراد به الحداثة اليوم، وإنما أعني تلقيح الأصيل بجديد يزداد به أصالة وعراقة كالبياض يمزج به قليل من اللون الأزرق فيزداد بياضا ونصاعة.
الحق أن أدبه مزيج بين القديم والجديد، سواء في ذلك شعره ونثره، فقد كان له نثر فني رائع في الرسائل الإخوانية التي نعطي عنه صورة رائعة كأديب واسع الثقافة محيط بالأحوال الاجتماعية حكيم في تدبير شؤون الحياة، قادر على التصرف في البيان، بقلم بديع ريان.
وألفت الأنظار إلى ما في كتاب الألغيات من هذه الرسائل التي ترسل فيها بلا قيود، ولكنها مرصعة بالطبعية والبلاغة العربية الأصيلة، على أنه له رسائل أخرى هناك كتب بها إلى أدباء المدرسة الألغية على النمط الأندلسي الصميم، مقيدة بأسجاع، وألوان البديع وفواصل إيقاع. وعلى مثل هذا يسير في القريض، ومرة مع القديم حتى يخيل لمن يقرؤه أنه يقرأ الشاعر القديم، ومرة أخرى مع الجديد فينقلك إلى دجلة والنيل مع شعرائهما في عشرينات هذا القرن.
فبينما يقول مثلا وهو يصف صبره على الأخطار في طلب العلم:
|
أريغ العلا بالنص في كل فـدفـد |
*** |
تظل به الخريت شتى المشاعـب |
|
أعرض حر الوجه نحـو سمومـه |
*** |
فيكسوه من أثواب سود غرابيـب |
|
فجبت الجبال الشامخات وخضخضت |
*** |
سراب البطاح الفيح هوج ركائبي |
أو يقول حين يصف العصيدة:
|
فيـاليـت شعري من تحط أمامـه |
*** |
فيوضع في الأطراف منها ويعنق |
|
ويخبط فيهـا باليـديـن كـأنمـا |
*** |
تخبطه وسـط الـدجنة أولــق |
|
يشـن عليهـا غـارة مشـمعلـة |
*** |
بقلم أكـول آمـن ليـس يرهـق |
|
فيـأتي على تلـك العصيدة كلهـا |
*** |
إذا الجفنة الغناء جـرداء سملـق |
بينما يقول كأنه يعارض النابغة والأعشى، إذا به يقول لبعض المعجبين به يلح عليه في أن ينشده من شعره:
|
أبـاعي في الشعـر لا يجـحـد |
*** |
أن يـــراعـي لا يـجـمـد |
إلى أن قال:
|
أيـا طـالب الشعـر ماذا تـرى |
*** |
أننشد مـا ضـاع أم ننـشـد؟ |
|
ألسـت تـرى المجـد مفـتقـدا |
*** |
أبــا لشعر يـرجع مــا يفقد؟ |
|
وشعبـي وشعبـك فـي كـمـد |
*** |
ونحـن بنــوه ألا نـكـمـد؟ |
ثم أنهى قصيدته بهذه الخاتمة:
|
خليـلـي ذلـك همـي ومـــا |
*** |
تحـــاول بعـد ومـا تقصـد؟ |
|
سلام علـى الشعـر حتـى أرى |
*** |
شعوب العروبـة لا تـضـهـد |
ويقول في ظروف ألحت عليه في القول فألح على شاعريته بالسؤال والاستغراب:
|
إلى أين ذياك البيـان الـذي أدرى |
*** |
فما هكذا عودت أن جئت للشعر؟ |
|
كأن لم أقل شعرا كأن لم تجل على |
*** |
سماوته روحي بأجنحـة النسـر؟ |
|
كأن لم لأقف في محفل بفصاحتـي |
*** |
فأغدو حضا هاج باللجج الخضر؟ |
|
أثير شعور السـامعيـن كـأنمـا |
*** |
دلفت إلى الجلاس في جحفل مجر |
ثم نراه في وصف الطبيعة يرسم لوحات رائعة لمناظرها الخلابة، وقد يكون أقوى إحساس وأملا وجدانا ونطا حين يصف منظرا جميلا ويرسم له صورة بديعة ببيانه المتدفق بلا قيود وعوارض.
وصف مثلا مناظر أبزو وإيموزار وبسيط إلغ المغطى بملاءة بيضاء من الثلج المشع. فكان شاعرا أندلسيا عاشق الطبيعة رفيع الذوق رائع التصوير.
وهكذا نرى شاعرنا يتردد بين القديم والجديد، وبين النفحات الأندلسية وبين اللفحات الملتهبة بالغيرة الوطنية على الأمجاد التي جهد الاحتلال نفسه في القضاء عليها.
لا أقصد هنا فتح باب النقد والتحليل لشعره الغزير الذي يعطي عنه صورا مختلفة الألوان والأحجام لأن موضوع الحديث لم يكن مداره إلا تردد شعره بين “قديم وجديد”والنكرة هنا لها مدلولها بمعنى أن القدم والجدة هنا سيان جدا.
إن تأثيره بالقديم وبالمدرسة التي تتلمذ عليها سابقا ظل ملازما له حتى آخر حياته الأدبية، إلا أن شعره سواء في انطلاقاته الجديدة أو في جريانه على الطريقة الإتباعية- لم تفارقه الروعة والقوة بمفهومهما النسبي.
ثم جاءت المرحلة التي انكب فيها على التأليف وتدوين الموسوعات، فدب إلى شعره الفتور الذي قيده عن التحليق، دون أن يهبط إلى مستوى التلفيف، كما أشار إلى هذه الظاهرة قائلا :
“كذلك كنت أقول في الحمراء، ثم ارتكس الفكر اليوم في “إلغ” ارتكاسا مخزنيا، ويا طالما حاولت أن أسمو ثانيا، ولكن يغلب على ضعف الأجنحة، فلا أكاد أحلق قليلا حتى أسف إلى الجو الذي اعتاده أخيرا، وسبب ذلك أنني هنا مشتغل بجمع كتب متعددة تتعلق بسوس. الألغيات ج3 ص 130.
وهذا عامل قوي لا نطيل بشرحه من حيث تأثيه السلبي في هذا الباب، وإنما نعبر منه إلى نافذة أخرى نطل منها على محمد المختار المؤلف الموسوعي بعدما ألممنا بشخصية محمد المختار الشاعر الأديب اللغوي، ظاهرتان في حياته بسببهما طارت له الشهرة خافقة، وأحاطت بشخصيته هالة من الشعبية وتقدير الأوساط المثقفة. وهما التدريس والتأليف، ففي السنوات التي تصدر فيها التعليم في مراكش استطاع أن يحرك هذه المدينة الساكنة، وأن يجمع حوله عشرات من الشباب المتعطش إلى المعرفة، يدرس لهم مختلف الفنون بجد وإخلاص، إلى جانب المجالس العامة التي يعقدها في المساجد الجامعة، وقد اكتسبت منذ ذلك الوقت شعبية عالية سلطت عليه عيون الاحتلال فتربص به الفرص حتى أبعده إلى “إلغ” وهناك بدأ عمله بعزيمة حديدية في إحياء تاريخ سوس الأدبي والعلمي ماضيه وحاضره، وقد كان مجهولا حتى عند الذين يعينهم هذا التاريخ، ويذكر ذلك في رسالة له فقال:
“… رأيت هذه الزاوية من المغرب مجهولة حتى عند المغاربة أنفسهم، فضلا عن العالم كله، فقلت في نفسي لأقم على حسب مستطاعي بإلقاء ضوء على تقلبات هذه الزاوية، فكان ذلك شغلي الواحيد منذ وطئت قدمي هذه الأرض”.
كان إنتاجه غزيرا كما هو معروف، وكان أديبا وهو تاريخ أو تراحم، أو مذكرات، لأن تعبيره الأدبي وأسلوبه الذاتي ورأيه الناقد، وتحليله الغالب الأحداث والوقائع… كل أولئك حاضر في إنتاجه كيفما كان لونه. وهذه المعطيات من أهم العوامل التي تضفي على كل إنتاج من هذا النوع، بصرف النظر عن مادته وموضوعه صفة الأدب كما أشرت إليه في بداية هذا الحديث.
فما قيمة هذا الإنتاج خارج ناحيته الأدبية؟
أما قيمته من حيث الدقة في النقل والتحليل والتعليل ومن حيث المنهجية فقد سبق صاحبه كل الملاحظين والناقدين إلى القول بأنه ألف ما ألف على أساس أنه مواد خام للذين سيأتون فيما بعد يبحثون عن المصادر والوثائق، فيجدون كل ذلك في متناول أيديهم، قد وفر لهم وكفوا اتعابا قد تكون عائقة لهم عن البحث في تاريخ ما أهمله التاريخ. قال في مقدمة المعسول:
“… لا أدعي أنني بلغت الغاية، أو اتبعت المنهج في الدقة، وإنما أدعي أنني حرصت على أمانة النقل عن المصادر..
الحق أن إنتاجه في التاريخ ذو ألوان مختلفة فمن كتاب “من أفواه الرجال” الذي قال عنه هو نفسه أنه أمشاج بسيط ساذج ولكنه أعز عندي من كل ما كتبته بعده.
إلى كتاب “المعسول” الذي أراد به أن يكون موسوعة للتراجم والتاريخ والأدب، ومعجم أدباء سوس، فحشر فيه كل ما يفيد الباحث والمؤرخ الذي يستنتج من كل شيء كما قال في مقدمته “إن المؤرخ يفرح بكل شيء ولو الخرافات فضلا عن الحقائق ..”
إلى “إليغ قديما وحديثا “هذا الكتاب الذي شارف قمة البحث المنهجي في التبويبي والترتيب ولتنسيق عناصر البحث، ونقد الروايات على ضوء المنطق والحتمية التاريخية والاجتماعية..
وبالرغم من ذلك فالدارس الناشيء يضيق صدره وهو يقرأه لأنه يشعر بانفلات رؤوس الخطوط التي بقيت في مصادر أخرى لا بد من الرجوع إليها لأخذ صورة شمولية لهيكل البحث العام.
وقد أتيح لهذا الكتاب القيم أن يتكامل ويسهل تناوله على الباحثين الناشئين، بفضل التعاليق الضافية التي وضعها عليه محققه الموقف الأديب البحاثة الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني حفظه الله.
وبعد، فقد كان أستاذنا محمد المختار قمة النشاط في حياته الأدبية والعلمية، وكان رائعا في العمل العظيم الذي أنجزه بالرغم من قيود النفي والاعتقال قبل الاستقلال، وقيود المسؤولية الحكومية بعد الاستقلال، وكلتاهما تحد من حرية الباحث وتفل من نشاطه الحاد ولكن الهمم العالية تفك القيود وتدك السدود، وتتحدى الأحداث إلى أبعد الحدود فقد وفق بين حريته ونزعته النفسية الجامحة، وبين البيئة التربوية والاجتماعية الكابحة، فكان صورة مشرقة لأديب مثالي وعالم سلفي، ومؤرخ موسوعي، كامتداد للمستوى الرفيع الذي كان العالم الحق يحتله في هذه الديار.