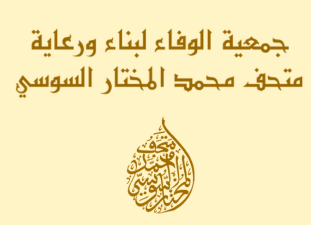مقومات نجاح العلامة محمد المختار السوسي في مشروعه الثقافي
بقلم الدكتور اليزيد الراضي
هناك أناس كثيرون يعبرون الدنيا كما يعبر النهر، يأتون إليها ويخرجون منها دون أن يكون لهم فيها أثر يذكر، ودون أن يخلفوا فيها ما يعطر ذكرهم بعد الموت.
وهناك أناس قليلون تركوا في الدنيا – بعد رحيلهم – دويا ما يزال صداه يتردد في أذن التاريخ، وما تزال الأجيال المتلاحقة تستفيد من عطائهم وتتزود مما خلفوا من فكر ثاقب، وآراء متبصرة، ومازالت بصماتهم الجميلة واضحة في التاريخ الإنساني، ومازال إسهامهم المتميز محفوظا لهم في سجل الحضارة البشرية.
ومن هذه الفئة الثانية القليلة، هذا الرجل العظيم، العلامة المؤرخ الأديب الوزير سيدي محمد المختار السوسي، الذي كان أمة وحده، ….وقدم من العطاء العلمي والأدبي ما لا تقدر على تقديم مثله المؤسسات المنظمة الممولة، لقد وجد – رحمه الله – تاريخ سوس العلمي والأدبي والسياسي، يعاني ما يعاني من الإهمال والتهميش من أبناء سوس أنفسهم – قبل غيرهم- فآلمه ذلك، وحزّ في نفسه أن تبقى هذه المنطقة الخصبة السخية، دون ذاكرة تعي دورها الكبير في بناء الصرح الحضاري المغربي والعربي والإنساني، واقتنع بأن العلاج وتدارك الأمر لا يكون بالتأسف والتأوه والتوجع، وإنما يكون بالتشمير عن ساعد الجد، والإقدام على عمل إيجابي طموح، قد يبدو في البداية مغامرة، ولكنه إذا صحت النية، وقويت العزيمة واتضحت الرؤية، واتخذت الإجراءات الضرورية، سيتحول إلى مشروع قابل للإنجاز، فنذر نفسه لخدمة هذه المنطقة التي تنطوي خدمتها على خدمة الوطن والعروبة والإسلام، وإسداء أياد بيضاء للأجيال اللاحقة، ورسم الخطة ووضع التصميم وبدأ بجد ونشاط وإخلاص في التنفيذ، فحقق بفضل الله نتائج باهرة، جعلتنا وجعلت غيرنا ننبهر بعظمة ما أسدى وكثرة ما أعطى، فقد أوقد الشموع في زوايا كثيرة مظلمة، وعبد الطريق في مهامه مقفرة، وزرع بذلك الثقة في النفوس ودفع الأجيال التي تأتي بعده برفق ولطف إلى ترسم خطاه، وإتمام ما بدأه، وبيّن للقاصي والداني، أن العزم الصادق يذلل الصعوبات، ويقرّب المسافات، ويصنع ما يشبه المعجزات، وأن ما تعلقت به همة ابن آدم تناله ولو كان في أعلى السماوات وأن التسويف والتماس الأعذار وانتظار الظروف المواتية عراقيل وعقبات في الطريق ومثبطات للعزائم، ورسائل للإحباط والإخلاد للراحة والكسل.
ويكفي المرء لكي ينبهر أمام ما قدّمه المحتفى به ويكبر جهاده وتضحياته وينوه بتوفيقه ونجاحه أن يعلم أم مؤلفاته المختلفة الأحجام والمتنوعة الموضوعات بلغ أزيد من 86 سفرا وشملت ميادين ثقافية عديدة من تاريخ ولغة وأدب وفقه وتحو وحديث ونقد وتصوف وغيرها..
فبماذا نجح العلامة محمد المختار السوسي؟ وبماذا حقق ما حقق؟ وما السر في نجاحه في مشروعه الثقافي الضخم الذي أسس به للسوسيين خاصة وللمغاربة عامة وللعرب والمسلمين والناس كافة بشكل أعم، خدمة جليلة، لا يستهين بها إلا من لا يعرف الفضل لذويه، ومن ينكر الشمس في رابعة النهار؟ وأظن أن الجواب عن هذه التساؤلات يمكن في الأمور الهامة الآتية:
1 – وضوح المشروع:
لم يقدم محمد المختار السوسي رحمه الله على ما أقدم عليه إلا بعد أن تبين مواقع خطاه وتبلور المشروع في ذهنه واتضحت الرؤية لما فيه الكفاية، وحدد الأهداف التي يسعى لتحقيقها، ولم يكن من الذين يقدمون على أمور ضبابية لم يتبينوها بعد ولا من الذين يمتشقون القلم ويكتبون دون وعي بما يكتبون، ودون معرفة بما يريدون، إنه رحمه الله واع تمام الوعي بما يصنع، ومقتنع تمام الاقتناع لأهمية ما أقدم عليه، ومسطر للأهداف النبيلة التي يعمل كل ما بوسعه لتحقيقها، فلم يكن عمله مغامرة، ولم يسر في الطريق المسدود، وإنما كان عمله مشروعا ثقافيا واضحا، يعرف ما يحيط به من صعوبات، وما يتطلب من تضحيات، ويعرف قيمة وأهمية النتائج التي سيسفر عنها.
ومقدمات مؤلفاته تكشف عن جديته في عمله، ووضوح مشروعه ورؤيته وأهدافه ولنقتصر في هذه العجالة، على مقدمة موسوعته النفسية المعسول التي ذكر فيها أهدافا واضحة جعلها نصب عينيه، وسعى وراء تحقيقها ومن أهمها:
أ – أنه لاحظ اندفاع الشباب المغربي بعد الاستقلال إلى معانقة الحضارة الغربية بما لها وبما عليها، مع ما رافق ذلك من التفريط في المثل الدينية العليا، والتفريط في اللغة العربية وآدابها، وهو رحمه الله موقن بأن الأجيال اللاحقة ستستعيد رشدها في يوم من الأيام، وستثور ضد العادات والأفكار الدخيلة التي لا تمت إلى شخصيتها وهويتها بصلة، ولذلك أراد أن يضع أمام هذه الأجيال المواد التي تمكنها من استعادة ذاكرتها واسترجاع أمجاد آبائها وأجدادها، قال رحمه الله:” فلهؤلاء يجب على من وفقه الله من أبناء اليوم أن يسعى في إيجاد المواد الخام لهم في كل ناحية من النواحي التي تندثر بين أعيننا اليوم، وما ذلك إلا بإيجاد مراجع للتاريخ يسجل فيها عن أمس كل ما يمكن من الأخبار والعادات والأعمال والمحافظة على المثل العليا، بل يسجل فيه كل ما كان ولو الخرافات، أو ما يشبه الخرافات، فإن نهم من سيأتون في الغد سيلتهم كل ما يقدم له كيفما كان، ليستنتج منه ما يريد أن يعرفه عن ماضي أجداده، وهذا أحد مغازي هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ.” ( [1] )
ب – أنه عندما زار الزاوية الدلائية، ولاحظ اندثار أخبارها وآثار علمائها، تأكد لديه أن الخلود للعلماء والأدباء لا يكون إلا بالتسجيل بالأقلام، وتذكر سوس التي تحتضن من أمثال الزاوية الدلائية العشرات، فاختمرت في ذهنه فكرة تسجيل أخبار علماء سوس وأدبائها وانتظر الفرصة المواتية فكان نفيه إلى إلغ سنة 1355ﻫ بداية هذه الفرصة. ( [2] )
ج – أنه عندما كان منفيا لمسقط رأسه إلغ، بدأ يسجل الرواية الشفوية من أفواه الرجال مادة لكتابه من ” أفواه الرجال” ، وجده أخوه احمد عشية يوم مكبا على تسجيل كل ما يسمع، فقال له: ” ماذا تصنع الآن؟ فإن كنت لابد كاتبا، فهيئ لنا كتابا عن إلغ وعن كل من مر فيه من العلماء والأدباء والحوادث ليكون ككتاب آل زاوية تيمگدشت الذي ألفه العربي المشرفي الفاسي، ( [3] ) قال المختار السوسي:” فكانت هذه الكلمة من الأخ هي البذرة الأولى من هذا الكتاب، ثم نظمته تنظيما يكاد يستوفي كل أعمال زوايا سوس ومدارسها، مع الإلمام بأخبار بعض رؤسائها والحروب بينهم وجميع رجالات الأسر العلمية تفصيلا..” ( [4] )
د – أنه أراد أن يعرف القراء بإسهام السوسيين الأمازيغ في خدمة اللغة العربية، ونشر علومها وآدابها، قال:” لأن المقصود أولا وآخرا أن يرى القارئ مشاهدة ما يقوم به جانب من جوانب المغرب، يضم طائفة من أبناء أمازيغ الشلحيين البدويين، في نشر اللغة العربية وعلومها وآدابها وقد أولعوا بذلك ولوعا غريبا، فقاموا بأعظم دور في ذلك بجهودهم الخاصة من غير أن تعينهم الدولة.” ( [5] )
ﻫ – أراد أن يعبد الطريق لمن يأتي يعده، وأن يشجعه على مواصلة السير لتنمية المشروع وتطويره، قال:” نطلب الله أن يأتي بمن يستتم ما ينقص الموضوع، أو يصحح الأغلاط، وما ذلك على شبابنا الذي نراه يشارك اليوم في هذا الميدان ببعيد”. ( [6] )
2 – امتلاك مقومات التأليف:
لم يتصد المختار السوسي رحمه الله للتأليف، ولم يقتحم غمار البحث الجاد الهادف، ولم ينطلق في إنجاز مشروعه الثقافي الطموح، إلا بعد أن استعد لذلك استعدادا كافيا، وامتلك الأدوات الضرورية، وحمل معه جواز المرور إلى ذلك العالم الفسيح فهو لم يتطاول على التأليف، ولم يتطفل على درب لا يحسن السير فيه، ولم يكن ممن يقال لهم ليس هذا بعشك فادرجي، وإنما أتى بيوت التأليف من أبوابها، وتصدى لفتح أبواب يملك مفاتيحها، وسار في طريق لا تعثر فيها رجله، ولا تحار فيها قطاته. ويمكن أن نختزل مقومات التأليف التي امتلكها فيما يلي:
أ – الكفاءة العلمية، فهو رحمه الله عالم متمكن، درس العلوم اللغوية والشرعية الرائجة في سوس خاصة وفي المغرب عامة، وتفوق فيما درس، وأتقن الفنون العلمية التي تعاطاها، وأضاف إلى دراسته المنظمة دراسته الحرة التي تمثلت في إقباله على المطالعة، وشغفه بالقراءة خاصة في مجال التاريخ والأدب، كما قال – متحدثا عن نفسه – :” فقد أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري، وميزت يميني من شمالي، بالتاريخ والأدب، وبمطالعة كتبهما، فلا أظل ولا أبيت منذ كحلتني العربية بإثمدها، وأذاقتني حلاوة معانيها الطلية، فأنستني بخمرتها، إلا بين كتاب أبتدئه وآخر اختتمه..” ( [7] ) فاتسعت مداركه، ونما رصيده المعرفي، وعلا كعبه في كثير من المجالات الثقافية، وأصبح مشاركا موسوعي الثقافة.
وهذا التمكن العلمي جعل مؤلفاته جمّة الفوائد غزيرة العوائد، توسع الأفق المعرفي للقارئ، وتشحذ ذهنه، وتنور فكره، وتزوده برصيد علمي هام، ويتسم بالغنى والعمق والسداد، ويصدق عليها قول القائل:
|
يزيدــك وجهــه حسنـــا
|
|
إذا مــا زدتــه نظــرا
|
ب – الكفاءة اللغوية: أعطى المختار السوسي للغة العربية وعلومها وآدابها عناية خاصة، أيام دراسته وطيلة حياته، فحقق فيها نتائج باهرة، وتضلع فيها تضلعا غريبا، وبذ فيها أقرانه من البدويين والحضريين، بالرغم من انتمائه إلى العنصر الأمازيغي، فلنستمع إليه يتحدث عن نفسه وعن أدباء إلغ، ويقول: ” فالحمد لله الذي هدانا حتى صرنا – نحن أبناء إلغ العجم – نتذوق حلاوتها [ أي حلاوة العربية ] وندرك طلاوتها، ونستشف آدابها، ونخوض أمواج قوافيها، حتى لنعد أنفسنا من أبناء يعرب، وإن لم نكن إلا ،بناء امازيغ، فالإنسان بذوقه وبما يستحليه عند التعبير، لا بما رضعه من ثدي أمهاته، واللسان بما تفتح له به المعاني الحلوة لا بما يتهدج به من لغة يرثها لا تعد من نبع ولا غرب؟ فاللغة العربية عندنا – معشر الإلغيين – هي لغتنا حقا التي نعتز بها، لأن بها مراسلتنا ومخاطبتنا حين نريد أن نرتفع بأنفسنا عن مستوى جيراننا وأبناء جلدتنا من الحربليين والوفقاويين والمجاطيين والساموكنيين، وتلك نعمة أنعم الله بها علينا بفضله وكرمه، حتى إننا لنرى أنفسنا من ورثة الأدب العربي، فنغار إن مسّه ماس بفهاهة، وتدود عن حماه إن أحسسنا بمن يريد أن يمسه بإهانة، فنحن عرب أقحاح من حرشة الضباب، والمستطيبين للشيح والقيصوم، وإن لم تكن أصولنا إلا من هؤلاء الذين يجاوروننا من أبناء الشلحيين الأماجد.” ( [8] )
وتتجلى الكفاءة اللغوية عند المختار السوسي في مظاهر عديدة أهمها ثلاثة:
۱– الإلمام الواسع بمتن اللغة العربية، لدرج أنه أصبح عمدة في القاموس كما يؤيد ذلك طلب بعض زملائه منه في منفى أغبالو نكردوس أن يدرس لهم القاموس، قال رحمه الله في معرض حديثه عن النشاط الدراسي العجيب الذي شهده ذلك المعتقل: “ولمعرفة الناس هنا بكلفي بالتعليم وبالتعلم، صار كل واحد يقترح عليّ درسا خاصا، حتى الأستاذ الفاسي اقترح أن نمر بالقاموس، كما اقترحه أيضا الأستاذ الكتاني.” ( [9] )
۲– حذق علوم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، كما تشهد بذلك مجالسه التعليمية في الحمراء، وفي معتقل الصحراء، وما خلفته تلك المجالس من دروس محررة قيّمة. ( [10] )
۳– التحكم في ناصية اللغة العربية، والعلم الواسع باستعمالاتها الحقيقية والمجازية والقدرة الفائقة على التعبير الرصين بأسلوب أدبي جميل يتجاوز الإفادة والإقناع إلى الإطراب والإمتاع.
ولاشك أن الكفاءة اللغوية العالية التي كان المختار السوسي يتحلى بها كان لها دور كبير في نجاح مشروعه الثقافي، لأنها ضمنت لمؤلفاته الفائدة والمتعة وجعلت جسور التواصل ممتدة باستمرار بيته وبين قرائه، فعلى الرغم من كثرة ما كتب وحرر، ووفرة ما قيّد وسطّر، لا نشعر بضعف في عباراته أو ركاكة في أسلوبه بل نحس في كل ما كتب بالجزالة والقوة، ونحس بحلاوة البيان، وروعة العبارة وإشراق الديباجة، وتمام الوضوح ودقة التنظيم.
ج – الكفاءة المنهجية: إن سلامة المنهج وصلاحيته، من الشروط الأساسية لنجاح أي مشروع ثقافي كيفما كان حجمه وطبيعته، ولذلك نرى أن الكفاءة المنهجية لا تغني عنها الكفاءاتان العلمية واللغوية، لأن المنهج السليم، هو الذي يحول العلم واللغة إلى بناء متماسك يقي الذهن والوجدان من حر وبرد الفوضى والاضطراب، فلا علم بدون ترتيب وتنظيم ولا ترتيب ولا تنظيم بدون منهج سليم.
والعلامة المختار السوسي رزق في كل ما خطّه يراعه منهجا سليما، سدد خطاه على محجة البحث العلمي الجاد، وأخذ بيده وهو يجول في عالم مشروعه الثقافي الفسيح، فلم تتعثر خطواته، وتضطرب أفكاره، ولم يتلعثم لسانه، ولم تحر قطاته، ولم يرهق نفسه ولا قراءه.
وتتجلى الكفاءة المنهجية عند المختار السوسي – أكثر ما تتجلى – في الأمور الآتية:
۱– التصميم المحكم المبني على رؤية واضحة أبرزت خبايا المشروع، ووقفت على مكوناته ومقاصده، وأدركت إدراكا واعيا أهدافه القريبة والبعيدة ومراميه المعلنة والمضمرة.
وإذا كان كل كتاب من كتب المختار السوسي يخضع لتصميم محكم ويتناسل وفق خطة دقيقة، فإن مشروعه الثقافي الضخم بكل مكوناته ومقوماته يخضع أيضا لتصميم دقيق، جعل مكوناته تتعانق فيما بينها وتتجاوب ويكمل بعضها بعضا، فما أشبه مشروعه الثقافي بكتاب، وما أشبه مؤلفاته المختلفة بفصول وأبواب ذلك الكتاب، فقد جعل كتابه ” سوس العالمة” مدخلا لكتبه الأخرى، وخصص ” المعسول ” للإلغيين العلماء والأدباء والصلحاء ومن إليهم من الشيوخ والتلامذة والأصدقاء، وخصص ” مترعات الكؤوس ” للأدب العالي، وخصص ” إيليغ قديما وحديثا ” لإمارة التازروالتيين أبناء الشيخ أحمد بن موسى السملالي، وخصص ” رجالات العلم العربي في سوس ” لعلماء هذه المنطقة الجنوبية، وخصص ” مدارس سوس العتيقة ” للمؤسسات التعليمية التي يرجع إليها الفضل في النهضة العلمية والأدبية والدينية التي عرفتها منطقة سوس، وخصص ” خلال جزولة ” للحديث عن بوادي سوس وحواضره وخزائنه العلمية وما إلى ذلك، وخصص الإلغيات للمساجلات والمذاكرات التي شهدها مسقط رأسه عندما نفي إليه، وخصص ” الترياق المداوي ” للحديث عن والده باعتباره زعيم طريقة صوفية كثر أتباعها وذاع صيتها داخل سوس وخارجه..
وهكذا نجد أن كل كتاب من كتبه يضيء زاوية من زوايا مشروعه الثقافي، وأن كل بحث من بحوثه يسهم إسهاما واضحا في الكشف عن أمجاد سوس العلمية والأدبية والدينية والاجتماعية والسياسية.
۲– طريقة التناول المتسمة بالحيوية والتنوع والمطبوعة بطابع العمق والشمول، فهو عندما يتناول موضوعا يشبعه بحثا ويأتيه من كل جوانبه ويستعين في ذلك بتقنيات عديدة منها:
– تقنية الوصف المتتبع للتفاصيل والجزئيات والكاشف عن كل الملامح والقسمات، وقد وصف الأماكن والأعلام والمكتبات ومحتوياتها.
– تقنية التحليل المعتمد على الشرح والتفكيك والتركيب والمناقشة والتعليق.
– تقنية النقد الجامع بين الاحتكام إلى القواعد والأصول المقررة والاحتكام إلى الذوق الأصيل المستمد من رهافة الحس، والملكة الأدبية العالية.
– تقنية الاستطراد الذي يوسع أفق البحث، ويثري مضمونه الفكري ويجعله منجما فكريا متنوع المعادن.
– تقنية المقارنة التي تعتمد أسلوب الموازنة، وتستهدف مقابلة الأشياء بعضها ببعض، لإدراك ما بينها من فروق والوقوف على أوجه الشبه وأوجه لاختلاف بينها.
۳ – التنظيم والترتيب: اللذين يعتبران الطابع العام لكل ما كتب، فلا نجد في مؤلفاته الفوضى الفكرية والاضطراب المعرفي، بل نجد أفكارا منسقة ومعلومات منضبطة منظمة، تتعانق فيما بينها وتتجاوب وتتكامل، والمعلومات المنظمة بسهل فهمها واستيعابها على القراء بينما المعلومات المشوشة تشوش الفكر، وتبلبل الأذهان، والتنظيم يقي من آفتي التكرار والتناقض، اللتان تفسدان جوا التأليف، وتربكان القراء.
د – الشجاعة الأدبية: لقد تحلى المختار السوسي بشجاعة أدبية عالية جعلته يعبر عن آرائه وتصوراته بمنتهى الصراحة والوضوح، دون شعور بأي حرج أو أي مركب نقص، ويدافع عما يعتقده صوابا دون خوف من أي انتقاد أو اعتراض. وإذا كان العرب يقولون منذ القديم: “من ألف فقد استهدف” فإن هذه القولة وما تشير إليه من ولع الناس بالاعتراض والانتقاد والإنكار، لم تفتّ في عضد محمد المختار السوسي، ولم تزرع في نفسه الخوف والحذر لأنه واثق بعلمه وواثق بأسلوبه، وواثق بمنهجه، ومقتنع بأهمية مشروعه الثقافي وفوائده الكثيرة وإيجابياته الوفيرة، ومكاسبه الثمينة، “ومن عرف ما قصد هان عليه ما وجد”.
ومعلوم أن انعدام الشجاعة الأدبية، عائق كبير من عوائق التأليف، وسبب واضح من أسباب التزام الصمت، والرضا من الغنيمة بالإياب، فهو الذي جنى على كثير من علماء المغرب عامة، وعلماء سوس خاصة، وأقعدهم عن التأليف، وأخرس ألسنتهم وأقلامهم عن التعبير عن أفكارهم وآرائهم، إنهم بدون شك يملكون أدوات التأليف ويستطيعون أن يفيدوا الأجيال اللاحقة بإنتاجهم العلمي والأدبي، ولكن بسبب إفراطهم في التواضع من جهة ونقصان الشجاعة الأدبية من جهة ثانية تهيبوا النقد والتعليق، فتركوا ميدان التأليف، وحرموا الأمة من بنات أفكارهم وثمرات أقلامهم.
ومن هؤلاء طائفة اقتحمت ميدان التأليف على استحياء وأنتجت وأبدعت، ولكن لتواضعها الزائد، وعدم تحليها بالقدر الطافي من الشجاعة الأدبية، احتفظت بما ألفت وأبدعت فلم تخرجه للناس ليقرؤوه وينتفعوا به، ومن هذه الطائفة من أحرق في آخر عمره ما كتب خوف أن يعثر عليه الناس بعد موته فيقرؤوه وينتقدوا ويعارضوا.
وكل هذه الهواجس والأوهام، وما تجره وراءها من بواعث الانهزام النفسي والإخلاد للراحة والكسل، تخلص منها العلامة محمد المختار السوسي، فتصدى للتأليف وأتى البيوت من أبوابها الواسعة، وأخرج للناس كل ما ألف مطبوعا أو مخطوطا مؤمنا بأهمية التأليف – بالنسبة للمؤلف والقارئ معا – في تنوير الفكر وشحذ القرائح والعزائم، وصقل الأذواق وإثراء الرصيد العلمي والأدبي.
3 – الأخلاق العالية:
لقد أسهمت أخلاق محمد المختار السوسي إسهاما كبيرا في إنجاح مشروعه الثقافي، وكانت وراء ما لقيته مؤلفاته المختلفة من تنويه واستحسان ذلك أن كل من قرأ مؤلفاته، يحس بأخلاقه القويمة الرفيعة، تطل من بين السطور، فيزداد حبا له ولمؤلفاته.
وهذه الخلاق العالية التي ضمن بها لمؤلفاته حب الناس لها وإقبالهم عليها وشغفهم بقراءتها، واستحسانهم لما ورد فيها، يمكن أن نجمل أهم ملامحها فيما يلي:
۱– التواضع الجمّ، الذي ترشح به كلماته وعباراته، فهو رحمه الله لا يتعالى ولا يتعالم ولا يدعي التفوق على الأقران، بل يهضم نفسه، ويتظاهر بأنه أقل الناس علما وفهما، وكثيرا ما يعلق على إطراء الناس له بقوله: “وليس ثمة إلا فضل الله” أو “الشوهاء لا ينفعها الحلي.” وهذا التواضع الصادق جعله في عيون الناس أكثر ارتفاعا وأسمى مقاما، ومن تواضع لله فقد رفعه.
۲ – سلامة الطوية: وما تولد عنها من حسن النية والإخلاص في العمل، فقد كان رحمه الله سليم الطوية لا يعادي أحدا ولا يحقد عليه، ولا يسعى في مؤلفاته وراء الانتقام والتشويه والتحطيم والتنقيص، بل كان هدفه بعث التراث، وإحياء المجد العلمي والأدبي والسياسي لمنطقة سوس، فبارك الله عمله، ورتّب على أسبابه ومقدماته أحسن المسببات وأروع النتائج، فحقق في عمر قصير لا يتجاوز 63 سنة ما ينوء بالعصبة أولي القوة في زمن طويل، وصدق القائل:
|
لكن سـر الله في صدق الطلـب
|
|
كم ريء في أصحابه من العجب
|
۳– الاعتدال والانفتاح المتولدين عن الجمع بين التفقه في الدين والتفقه في الواقع، وقد مكنه الاعتدال من تحاشي الإفراط والتفريط في أحكامه وتعليقاته ومكنه الانفتاح من النظر إلى الحياة والأحياء من زوايا متعددة، لا من زاوية واحدة وكل ذلك جعله محبوبا عند الجميع، وجعل كتبه محل ثقة وتقدير الخاصة والعامة لأن كل من قرأها يجد فيها بغيته وتلبي رغبته ويحس بأن مؤلفها يكتب له، ويتجاوب معه، فقيها كان أو أديبا أو صوفيا أو مؤرخا أو غير هؤلاء.
وإذا كان بعض المؤلفين ممن لا خلاق لهم ينصرفون عن التأليف الهادف الجاد، إلى نشر المثالب ونهش الأعراض، فإن المختار السوسي رحمه الله لم يسر – في يوم من الأيام – في هذا الاتجاه، ولم يجعل من أهدافه فيما يكتب لمز الناس، والتماس مساوئهم وتنقيصهم وإنما مضى في مؤلفاته كلها إلى ما هو يصدده، وهو إحياء الأمجاد، ونشر المكارم والإشادة بالفضلاء، بعيدا عن أي تشويه أو تسفيه.
وحافظ على أخلاقه العالية، وما ترشح به من رزانة، وهدوء، ونزاهة وموضوعية وإنصاف في كل مؤلفاته، فكان الجو الذي ساد مؤلفاته جوا أخلاقيا مريحا، لم يكهربه الانفعال والتشنج، ولم يفسده التعالي والتطاول، والقارئ يحس بذلك الجو المنعش، فيرتاح إليه، ويمضي في القراءة دون ملل ودون كلل، ويرد لسان حاله قول المتنبي:
|
هكــذا هكــذا وإلا فــلا لا
|
|
طرق الجد غير طرق المزاح
|
٤ – استغلال الفرص: من أسباب نجاح العلامة السوسي في مشروعه الثقافي استغلاله لكل الفرص السانحة، فقد كان الهاجس الذي دفعه إلى البحث عن المعلومات العلمية والأدبية والتاريخية، وامتشاق القلم لتدوينها، وهو رغبته الملحة في كشف النقاب عن وجه سوس الثقافي والحضاري الجميل، الذي حجبه الإهمال عن الأعين، وتراكم عليه غبار السنين الطويلة، فستر حسنه وبهاءه، وأصبح كثير من الناس يظنون أن سوس بلد قفر لم تنبت تربته علما ولم ينجب أبناؤه علماء ولا أدباء.
وكان السوسي رحمه الله – رغبة منه في تحقيق هذا الهدف العلمي النبيل – يجد ويجتهد ويواصل عمل ليله بعمل نهاره، لطي المراحل وتذليل الصعوبات- وما أكثرها – واقتحام العقبات – وما أصعبها – وتقريب المسافات – وما أبعدها – وهو موقن بأن الفرص إنما هي ومضات سريعة، تلمع ثم تختفي، وتسنح ثم تستعصي، فمن توانى في انتهازها، وتريث في استغلالها، واغتنام خيرها، والتعرض لنفحاتها وبركاتها، يلحقه الندم حين لا ينفع الندم، ومن شمّر عن ساعد الجد، وكد وضحى، ولم يسوف ولم يؤخر عمل يومه إلى غده، واستبق إلى تقييد الأوابد، وجمع الشوارد، حمد ما صنع، ووجد بركة مبادرته إلى الخير، وصدق عليه قولهم : “عند الصباح يحمد القوم السرى.”
ولذلك آلى العلامة السوسي على نفسه، ألا يضيع وقته وجهده، فيما تضيع فيه أوقات وجهود الكثيرين، واستغل ما وهبه الله من قدرات وإمكانيات أحسن استغلال، فكان لا يرى إلا حاملا لكتاب يقرؤه، أو زائرا لمكتبة ذات أعلاق أو حاملا للقلم والقرطاس يسجل ويدوّن، أو سائلا لأصحاب الذاكرات العلمية والأدبية والتاريخية، ينقذ العلم والعلماء، والأدب والأدباء من مخالب النسيان التي لا ترحم، واستعان في هذه المهمة الشاقة بتلاميذه وأصدقائه، وجندهم جميعا للإسهام – بشكل أو بآخر – في إنجاح هذا المشروع الضخم، فمنهم من كلفه بالنقل من المخطوطات والوثائق، ومنهم من كلفه بتحرير تراجم علماء أسرته، ومنهم من كلفه بالرقن على الآلة الكاتبة، ومنهم من كلفه بالتنظيم والتبويب والترتيب.
وهكذا نجد أن العلامة السوسي أخلص لمشروعه إخلاصا منقطع النظير، فعمل كل ما بوسعه للوفاء بوعده، وكرس حياته لخدمته والنهوض بأعبائه، ووجه طاقته لتذليل صعابه، وتجاوز عقابه، واستغلاله للفرص يتجلى في أمور عديدة منها”
– أنه لا يضيع الوقت: إن زار عالما استغل زيارته للإطلاع على خزانته وذاكرته والاستفادة من معارفه.
– وأنه يستغل تلاميذه وأصدقاءه فيشركهم في همه الثقافي ويجعلهم عناصر إيجابية في خدمة مشروعه.
– وأنه يستغل نفيه، ويحوله من نقمة إلى نعمة، ومن محنة إلى منحة، فقد أستغل نفيه إلى مسقط رأسه إلغ في جمع مواد موسوعته ” المعسول ” وجمع مواد مؤلفات أخرى، واستغل نفيه إلى تنجداد وأغبالو نكردوس في جمع مادة كتابه معتقل الصحراء.
– أنه يستغل جولاته ويحولها إلى ورشة بحث وتنقيب، فقد استغل جولته في ربوع جزولة – عندما سمحت له سلطات الحماية بذلك – في جمع مواد كتابه خلال جزولة بأجزائه الأربعة وكتبه الأخرى.
– أنه يستغل تواصله مع أصدقائه عن طريق الرسائل، فينقل إليهم عبر تلك الرسائل همه الثقافي، ويحملهم على التجاوب معه ومساعدته.
– وأنه يستغل منصبه السياسي، ويحوله بكيفية أو بأخرى إلى منصب ثقافي ساعده على تحقيق أحلامه، وإنجاز مشروعه، فقد استغل الوزارة المسندة إليه – سواء في إطار وزارة الأوقاف، أو في إطار وزارة التاج – لتحقيق أهدافه الثقافية، ووظف الإمكانيات المتوافرة لديه، بسبب هذا المنصب لخدمة مشروعه الثقافي.
– وأنه يستغل مكانة والده الشيخ الحاج علي الدرقاوي، ويستفيد منها على المستوى الثقافي، لقد مكنته بنوته للشيخ الدرقاوي من حب الناس له، واحترامهم له، وثقتهم به، وعلى رأس محبيه ومحترميه مريدو هذه الطريقة، فاستغل ذلك أحسن استغلال، ووجهه وجهة صحيحة، وتجاوز به الإطار الصوفي الضيف إلى الإطار الثقافي الواسع، وكان استغلاله الإيجابي البناء لهذه الآصرة الدينية القوية، مساعدا قويا على تحقيق أهدافه العلمية، وبناء مشروعه الثقافي الطموح.
الهوامش:
[1] – المعسول1/د.
[2] – المصدر نفسه.
[3] – نفسه، ص: ﻫ.
[4] – نفسه، ص: و.
[5] – نفسه.
[6] – نفسه، ص: ز.
[7] – نفسه، ص: 14.
[8] – نفسه، ص: 13.
[9] – معتقل الصحراء1/201.
[10] – المصدر نفسه، ص: 196، 198، 200.